انبعاث فقه السياسة
لن نتحدث عن اسباب ضمور المباحث السياسية في الفقه الاسلامي لدى المدرستين: السنية والشيعية (الامامية خصوصا)، لان عددا من الدراسات والبحوث تناولت هذه الاسباب بالبحث والمعالجة، وتمت مناقشتها في غير كتاب وندوة ومؤتمر. وكان من نتائج هذه البحوث الدعوة الى تجاوز هذه الاسباب والمعوقات والخوض بجد في هذا المجال الذي ظل ممنوعا الاقتراب منه، خوفا من العواقب السيئة. وهكذا، واستجابة للمتغيرات التي عصفت بالعالم الاسلامي، وما نجم عنها من بزوغ لفجر الصحوة الاسلامية، وانطلاق الدعوات لاقامة الدولة الاسلامية والاحتكام للشريعة، بدات حركة التأصيل الاسلامي للمجال السياسي، بالبحث في مشروعية الدولة الاسلامية وضرورة اقامتها، وكيفية عملها وعلاقة الحاكم بالمحكوم في اطارها، والحقوق السياسية للمواطن المسلم، وغيرها من القضايا المهمة ذات العلاقة بالمذهب والنظام السياسي الاسلامي ككل. لن نستطيع، في هذه العجالة، ان نقدم تقييما مفصلا لهذه الجهود التأصيلية، لكن تراكما نسبيا يمكن الحديث عن تحققه خلال المئة سنة الماضية، استطاع ان يكشف عن طبيعة النظام السياسي الاسلامي في الكثير من تفاصيله، لكن عددا من الاسئلة لا تزال معلقة، منها ما يتعلق بالموقف من الماضي وتأثير التجارب التاريخية الاسلامية (خصوصا تجربة الخلافة الراشدة؟!) على توجيه هذا التأصيل وربطه بهذه التجارب، ما يشكل عائقا امام تحرره من سلبياتها، ومن الرؤية التأويلية والاجتهادية التي تحكمت بها.
وهذه من الاشكالات الكبرى التي عانت منها، ولا تزال، مجمل الجهود التأصيلية (السنية خصوصا)، فاي نقد يوجه لتجربة الخلافة الراشدة قد يثير التيارات السلفية المحافظة، التي جعلت من هذه التجربة نوعا من «الطوبى » لا يمكن الوصول اليها، او حتى تقليدها، فهي بمثابة «السقف والحلم » الذي لن يتحقق مرة اخرى. وهذه الاحكام او القناعات اللاعقلانية، لا يمكن تسويغها بتقديس هذه التجربة ومعها الحقبة الزمنية التاريخية التي حصلت فيها، لان هذه التجربة لم تخل من الاشكالات النظرية والعملية، وعند تحليل معطياتها بنظرة علمية فاحصة تنكشف للباحث انها لم تكن سوى تجربة لها ايجابياتها، كما لها سلبياتها وان الانموذج المثال الاسلامي الكامل لم يتحقق معها. ويكفي ان نعرف ان زعماء هذه التجربة، ونقصد بهم الخلفاء الثلاثة (عمر وعثمان والامام علي(ع))، قد قتلوا، وحدثت فتن واضطرابات سياسية خطيرة رسمت اخاديدا وتشوهات عميقة في تاريخ الاسلام، لذلك نلاحظ ان حركة التأصيل كانت واعية بهذا المأزق، فنجدها تستعين بالنصوص القرآنية والحديثية للحديث عن تفاصيل نظام الحكم الاسلامي، بعيدا في الكثير من الاحيان عن معطيات التجربة التاريخية. اما انموذج الخلافة والملك العضوض الذي نشأ مع بني امية وبني العباس ومن جاء بعدهم، فالكثير من المفكرين الاسلاميين المعاصرين لا يعدونه انموذجا يمكن الاقتداء به او الاستفادة من تجاربه، سواء في الشكل ام في المضمون، ويؤكدون انه كان نظام حكم استبداديا لم يتمثل قيم الرسالة الاسلامية، ولم يعمل على تحقيق مقاصدها، وانما اتخذ الاسلام مطية للاستقواء السياسي، وهذا ما يفسر كثرة الثورات والانتفاضات الشعبية التي قادها بعض العلماء وناصرها عدد كبير من الفقهاء والعامة.
من جهة اخرى، ظل منصب «الخلافة » نفسه موضع نقاش وسجال بين المدرستين: السنية والشيعية. لذلك لاحظنا ان جل الكتابات حول النظام السياسي كانت تنطلق من المسلمات التاريخية لدى اصحابها، واذا حدث ونوقشت هذه المسلمات، فانما لاستحضار الادلة الكلامية حول الامامة او الخلافة التي عرفها علماء الكلام داخل كل مدرسة، لذلك فمباحث المشروعية للنظام السياسي الاسلامي، لم تأت بجديد في هذا المجال سوى استحضار التراث واعادة عرضه باسلوب جديد (مع وجود بعض الاستثناءات بطبيعة الحال)، لكن الملاحظة الاهم هي تأثير الفكر السياسي الغربي في توجيه هذا التأصيل، اذ نجد ان معالجة نظام الحكم في الاسلام قد سارت على هدى الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر، وتمت صياغة مفهوم الدولة وطبيعتها ومسؤولياتها ووظائفها، وعلاقتها بالمجتمع وباقي المؤسسات داخل الدولة، على غرار انموذج الدولة القائم الآن في الغرب، انما في اطار مشروعية اسلامية نصية او عقلية (مقاصدية). وقد فجر هذا التأثر بالفكر السياسي الغربي عدة اشكاليات لا يزال الفكر السياسي الاسلامي يعالجها في اطار سجالي، مثل قضايا العلمانية والديمقراطية والحقوق السياسية للمواطن. ومن خلال هذا السجال، ظهرت وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، يحتمي بعضها بالتراث والتاريخ لرفض الانموذج الغربي للدولة والحكومة، وينفتح بعضها الآخر على التجربة الغربية للاستفادة منها، انسجاما مع سنن التطور، من دون ان يقطع صلاته مع تجارب الماضي والخصوصيات العقدية.
لكن الحدث المهم في حركة التأصيل هذه هو وصول الاسلاميين الشيعة الى الحكم في ايران بعد ثورة شعبية اطاحت بالملكية، واسست نظاما سياسيا فريدا غير مسبوق في التاريخ الاسلامي يجمع بين الاصالة والمعاصرة. والمفارقة هنا ان المدرسة الفقهية والكلامية الشيعية الامامية عاشت بعد غياب آخر ائمة اهل البيت (ع) محمد بن الحسن (الامام المهدي المنتظر) على انتظار الفرج (اي عودة الامام المهدي الذي سيطهر الارض من الظلم ويقيم دولة الايمان)، ولم تؤمن بضرورة العمل لاقامة دولة اسلامية، بل لم تؤمن كذلك بشرعية اي نظام سياسي يحكم في عصر الغيبة، لكن هذه القناعة السياسية والعقدية، سرعان ما بدأت تتغير مع مشاركة عدد من علماء الامامية في التوجيه الديني والمذهبي برعاية الدولة الصفوية التي انتصرت للمذهب الشيعي الامامي في ايران واسست دولة حديثة، اصبح لمؤسسة العلماء فيها مكانة مرموقة.
لكن موقف علماء الشيعة من الدولة الصفوية ساده الكثير من الحذر والتذبذب، بين الانخراط في دعم الدولة مطلقا او الابتعاد عنها. لكن الى هذه الحقبة يمكن ارجاع بداية اعادة التفكير في العلاقة مع الدولة. وقد ظهر لعدد من الفقهاء ان علاقة ما، مصلحية محدودة ومؤطرة، يمكنها ان تحقق بعض المصالح للمذهب وللمجتمع، وتجنب الفقهاء والمراجع مضايقة السلطات، كما حرصت الدولة، بدورها، على ارضاء المؤسسة العلمائية التي اصبح لها تأثير قوي في المجتمع. لكن على المستوى التنظيري لم يحصل اي تغيير معتبر سوى بعض المحاولات الرامية الى شرعنة بعض مسووليات الفقيه زمن الغيبة، مثل: ضرورة تقليد العامة للفقهاء، وضرورة تصدي هؤلاء للشأن الديني داخل المجتمع. وفي خضم هذه المحاولات التنظيرية، تحدث، لاول مرة، الشيخ الملا احمد النراقي (المتوفى سنة 1245هـ) في كتابه «عوائد الايام » عن ولاية الفقيه، هذه النظرية التي سيبلورها بعد ذلك الفقيه الامامي وقائد الثورة الاسلامية الامام الخميني، وسينشئ على اساسها الدولة الاسلامية في ايران.
اذن يمكن الحديث عن عاملين مهمين دفعا باتجاه اعادة النظر في فقه السياسة الاسلامي لدى المدرستين السنية والشيعية واحيائه، وتوجيه العقل الاسلامي للاجتهاد فيه، هما:
الصحوة الاسلامية التي شملت العالم الاسلامي ككل، والثورة الاسلامية في ايران التي اقامت دولة اسلامية ودخلت في تجربة جديدة للحكم الاسلامي. وهكذا اتجهت حركة التأصيل والتنظير السياسي في اتجاهين: الاول نظري يحاول اكتشاف ملامح النظام السياسي وطبيعة الحكم الاسلامي من خلال الاستفادة من الوحي والتراث والتاريخ، والثاني نظري وعملي معا، من خلال مواجهة الواقع وتحدياته والعمل على ايجاد انسجام بين القيم الاسلامية الثابتة في المجال السياسي، والآليات الاجرائية التنفيذية المتغيرة، وكذلك مناقشة القيم السياسية الجديدة التي كشف عنها التطور الحضاري الغربي المعاصر.
وكما قلت، سابقا، لا يمكن، في هذه العجالة، تقييم هذه الحركة التأصيلية والاجتهادية لبيان اوجه نجاحها وتفوقها او اخفاقها ومكامن الضعف في معالجة ذلك. لكن يمكن التأكيد على اهمية كونها قد وجهت الانظار الى انبعاث فقه السياسية، وخصوصا داخل المدرسة الفقهية الشيعية الامامية، التي فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه في هذا المجال، وهي تحاول الآن تأصيل نظرية ولاية الفقيه، وتعالج تداعياتها الواقعية او ترد على الاشكاليات التي طرحها خصوم هذه النظرية، وكذلك الابداعات المختلفة لنظريات سياسية، تحاول هي الاخرى ان تستمد مشروعيتها من الوحي والتراث، بحيث يمكن ان نتحدث عن تراكم نسبي تحقق في هذا المجال. وان كان القارئ العربي لا يعرف عن هذا التراكم الا قليلا بسبب عدم ترجمته الى اللغة العربية، مع ان هذا الاطلاع بالغ الاهمية في دعم حركة التأصيل الاسلامي للمجال السياسي العام، فلا يعقل ان ينطلق العقل الاسلامي في الضفة الاخرى (المدرسة السنية) من الصفر في معالجاته لبعض القضايا الشائكة، في الوقت الذي يكون العقل الاسلامي الشيعي والامامي قد خطا فيه خطوات كبيرة، وتجاوز العديد من العقبات.
نعتقد انه لم يعد هناك اي مسوغ لدى اي مدرسة فقهية او فكرية اسلامية لغلق الابواب على نفسها وتفضيل الاستفادة من الغرب المغايرر الحضاري، واهمال الآخر ضمن الدائرة الاسلامية. لا بد من الانفتاح على التراث الاسلامي بتياراته ومدارسه جميعها وامتداده عبر التاريخ والى الآن، اليست الحكمة ضالة المؤمن، وهو احق بها اينما وجدها؟! من هنا تنطلق قناعتنا لعرض هذا الكتاب الصادر حديثا عن دار الغدير لمؤلفه الايراني الدكتور محمد جواد لاريجاني، لانه قد يعد في نظرنا محطة مهمة في حركة هذا التأصيل، باتجاه البحث عن المشروعية العقلية للنظام السياسي الاسلامي، ولا شك في ان هذا المطلب ضروري ومهم، ويذكرنا بالابحاث الكلامية القديمة التي لم تكن تكتفي بالدليل النقلي اثناء الاحتجاج للتدليل على صحة رأي او معتقد، وانما لا بد من ايراد الدليل العقلي الذي يعضد الدليل النقلي ويسنده ويقويه، ويجعل بالتالي من المعتقد قيمة مطلقة ومتعالية، قائمة على الدليلين: النقلي والعقلي.
من هنا فاذا كان الفقه السياسي الشيعي قد قدم الادلة النقلية على مشروعية الدولة او الحكومة الاسلامية زمن غيبة الامام المعصوم، فهو هنا مع د. لاريجاني يحاول ان يبحث في الدليل العقلي لمشروعية الحكومة وفاعليتها، للوصول الى بناء نظرية سياسية اسلامية تقوم على الدليلين: النقلي والعقلي.
وهذا له اهميته، ليس في مجال البحث عن المشروعية السياسية فقط، وانما في الاجابة عن الكثير من التساؤلات المطروحة الآن حول عمل الحكومة في الجمهورية الاسلامية، اضافة الى تقديم انموذج جديد مغاير في فلسفته واصوله واهدافه للانموذج الغربي الليبرالي الذي يدعي بانه «نهاية التاريخ » ومبلغ الكمال الذي توصلت اليه البشرية عبر تاريخها، وهذا ما سيظهر بشكل واضح مع النقد العميق الذي وجهه د. لاريجاني لمفهوم الحكومة ذات الجذور الفكرية الليبرالية.
الحكومة الاسلامية والمشروعية
يرى د. لاريجاني ان قيام الدولة الاسلامية جعل الكثيرين يهتمون بمسألة الحكم ويولون قضاياه جزءا كبيرا من تفكيرهم، في الوقت الذي ادرك فيه رجال السلطة والسياسيون ان «ادارة الدولة تحتاج الى فكر منظم ومنسجم، وانها ليست مجرد مهارات فردية وآنية، وهذه دلالة في نظره على نضج النظام والشعب والحكومة »، لكنه يعترف بان «المعارف السياسية، بشكل عام، ما زالت غريبة بين علمائنا وباحثينا»، وما هذه البحوث والدراسات التي «تدور جميعها كما يقول حول تقديم بنية عقلانية للحكم والسلطة الا محاولة لسد هذا النقص ».
تبدأ عملية التأصيل العقلاني للحكومة، او اي نظام سياسي، بالاجابة عن مجموعة من الاسئلة الاساسية المهمة مثل: هل مصدر الاجتماع البشري المنتظم في اطار علاقات معينة، الفطرة البشرية او انه نتيجة تاريخية توصلت اليها البشرية؟ واذا افترضنا ان الانسان اختار الحياة الاجتماعية لافضليتها، فهل من الضروري اقامة حكومة؟ وما هو مصدر تلك الضرورة؟ هل هو الطبيعة البشرية او ضرورة العيش في مجتمع؟ او هو شي ء آخر؟ وهل تعد اقامة حكومة ما عملا عقلانيا؟ بهذه الاسئلة ومثيلاتها وما يتفرع عنها من تساؤلات، يعدها د. لاريجاني «اساسية في الفلسفة السياسية »، سيؤسس لفهم ما يأتي: اولا جذور الوضع الحالي (اي قيام الحكومة)، وثانيا ما يتعلق بماهية وظيفتها (التكليف) وتسويغها سياسيا.
يرى بعض الباحثين ان مسوغ الحياة الاجتماعية يكمن في اكتشاف الانسان انها تساعده في تأمين مطالبه الحياتية الضرورية. ولو صح هذا الادعاء يقول المؤلف فالحياة الاجتماعية تكون نتيجة لتحرك منطقي استطاع البشر ادراكه، وليس استجابة فطرية، لكن لكل تجمع ايجابيات وسلبيات.
بالنسبة للايجابيات لا بد من التساول عن سبل تحقيق افضلها واكثرها واحسنها، اما بالنسبة للسلبيات، مثل «مخاطر السرقة، القتل، الحرب »، فلا بد كذلك من البحث عن افضل السبل لتقليل هذه التهديدات. من خلال الاجابة عن التساؤلات لتجاوز السلبيات يظهر مفهوم الامن، اما التساؤلات حول تحقيق الايجابيات فتثير اسئلة معقدة وشائكة، فهل اهداف الانسان تنحصر في تحقيق ضروريات العيش او هناك اهداف اخرى؟ فعندما يتساءل الانسان: من انا؟ وما الذي يجب ان اقوم به؟ وما هو الكمال؟ ويستمر في طرح مثل هذه الاسئلة الوجودية، يصبح من الصعب تفسير سبب الحياة الاجتماعية بالحرص على تحقيق ضرورات العيش فقط او اي هدف آخر معقول، لان اي جواب عن هذه الاسئلة سيجعل الانسان يتعرف على طبيعته الميتافيزيقية. وهنا لا يمكن كما يقول لاريجاني للانتروبولوجيا او السوسيولوجيا، وحدهما، بيان سبب حياتنا بشكل جماعي ». فالبحث عن الكمال، او السعادة، مثلا ، يتطلب السعي الى تحقيق افضل تنظيم للجماعة يوصل للسعادة، وهنا تصبح السعادة مسألة اساسية في السياسة.
وعندما يتم فهم التفسير العقلاني للوضع (اي التنظيم السياسي)، سنكون امام تساؤلات جديدة من نوع آخر حول «بيان سبيل العمل »، او «الاجراء المعقول »، للوصول الى تلك الاهداف، وبالتالي سيتحدد البحث حول مفهوم المشروعية والفاعلية، وهذا المفهوم الاخير بدوره سيحيلنا الى مفاهيم اخرى ضرورية لفهمه، مثل مفهوم العمل الارادي وعقلانية العمل، ومن خلال معالجة هذه المفاهيم الاساسية يؤسس د. لاريجاني للمشروعية العقلية للحكومة الدينية.
بالرجوع الى الفكر السياسي اليوناني، نجد ان قضية السعادة كانت مسألة محورية، واليها تنتهي جميع الاسئلة الوجودية، وكذلك الاسئلة المتعلقة بضرورة المجتمع او العيش داخل اي تجمع بشري، وهذا ما نجده عند فيتاغوراس وسقراط وارسطو، بخلاف ما انتهى اليه الفكر السياسي الغربي الليبرالي الذي جعل «القدرة» محور ابحاثه السياسية، والسبب في هذا التحول هو الموقف من الاسئلة «الجذور»، او الوجودية، التي تحدثنا عنها قبل قليل، وكذلك بعده عن معالجة البعد الاخلاقي في السياسة، انطلاقا من قناعة مفادها ان لا فائدة من الاهتمام بهذه الاجوبة لاننا لن نصل الى حقيقة علمية تجريبية واقعية لهذه الاسئلة.
لكن هذا لا يعني ان مفهوم القدرة من ابتكار الفكر السياسي الحديث والمعاصر، فقد تحدث ارسطو، من قبل، عن هذا المفهوم وعده محورا اساسيا في مفهوم الحكومة، لان حقيقتها لا تظهر الا عند استخدام القدرة والسيادة. من هنا تطرح قضية المشروعية. هناك، مثلا، حكومة تمارس قدرتها وسيادتها انطلاقا من تميز عرقي، واخرى تأمر الناس باطاعتها لانها تملك وسائل القوة والقمع وتهدد من يعصيها بالقتل، وثالثة لديها مسوغات ايديولوجية اخرى، «وهناك مجموعة ممتازة ترى ان الصحيح هو ان نحكم، ولهذا حكمنا، وهذه الصحة مبنية على اساس البرهان والعقل ». هذه الحكومة يسميها المؤلف «حكومة العقل »، لان دليل مشروعيتها عقلي، حيث يؤمن الحاكم بحقيقة عقلية ويستسلم لها، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: «من اين جاءت هذه الصحة العقلية؟ وما هو مصدرها؟». للجواب عن هذا السؤال يرى المؤلف ان هناك نهجين اساسيين وقديمين جدا في مسألة المشروعية، الاول نهج اصالة النظام السياسي، ويمثله في الفكر السياسي الغربي الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز (ق 17)، والثاني نهج اصالة الوظيفة، ويمثله الفيلسوف اليوناني سقراط. ينطلق هوبز من مفهومين اساسيين هما: الوضع الطبيعي (اي استبداد الطبع البشري) والوضع المعقول (اي ضرورة الحفاظ على النفس)، ليصل الى ضرورة ان يفوض الناس بعض صلاحياتهم الى كيان يسمى «حكومة » مهمتها الحفاظ على الامن الخاص والعام.
ومشروعية الحكومة، هنا، تنبع من «العقد الاجتماعي »، اي توكيل الناس لها لتقوم بعمل خاص. وقد اثارت هذه النظرية الكثير من السجالات وانتقدت بشدة من طرف بعض التيارات الديمقراطية الليبرالية، لان هوبز يرى ان الحاكم الموكل من طرف الناس بآلية معينة يجب ان يكون مطلق السلطة. علاوة على ان قدراته ستكون بالضرورة اكبر من قدرات باقي الافراد.
لكن هناك استنتاجات مهمة يراها د. لاريجاني، من خلال عرض هذه النظرية ونقدها، فالالتزام السياسي، في هذه النظرية، ينبع اساسا من الوفاء بالعهد، كما ان حدود المشروعية يعد امرا مهما، لان الحكومة التي تتجاوز هذه الحدود تجابه بالرفض، اما من طريق مجلس النواب اذا وجد، او الثورة. اما المسألة الاهم فهي الوظيفة الاساسية لهذه الحكومة التي ستنحصر في قضايا الامن فقط، فليس من مسووليتها مثلا الارشاد، او هداية الناس فكريا واخلاقيا، فمن سيقوم بهذه المهمة؟ يتساءل د. لاريجاني انها اخطر نقطة ضعف في النظام السياسي الغربي المعاصر؟! وحتى عندما تشرع قوانين اخلاقية، مثل «العفة العامة »، مثلا، فان اصل هذه القوانين هو الحفاظ على الامن، مثل منع ممارسة الجنس في الشارع امام الناس، في الوقت الذي يباح فيه الشذوذ الجنسي، لانه من باب الحرية الشخصية؟! وتجدر الاشارة الى ان القانون في هذه الحكومة هو الذي يحدد الوظائف في ميدان مشروعية الحكومة.
اما نهج اصالة الوظيفة الذي يمثله سقراط الحكيم، فانه يتركز على مفاهيم مغايرة، فسقراط يؤمن باننا، بوصفنا بشرا، «نمتلك كمالا ذاتيا»، ولكل فرد كمالاته الذاتية الخاصة، لذلك يجب عليه ان يتحرك «باتجاه هذا الكمال الذاتي.. فمسؤولياته هي السير نحو الكمال الذاتي. ولا يعد «عملي » يقول لاريجاني «صالحا» الا عندما يوجهني نحو الكمال الذاتي، كما انه «ليست لي وظيفة اخرى سوى العمل الصالح...». وبناء على ذلك فتشكيل الحكومة، في نظر سقراط، ليس اصيلا «وانما الاصل كمال الفرد الذاتي، واذا ما وصلنا الى ضرورة تشكيل الحكومة يجب ان تكون باتجاه كمال الفرد، والا لا حاجة لوجودها»، ومشروعية الحكومة هنا تستنتج من حيث صلاح العمل، فتصبح مفردات العمل الحكومي في هذه الحكومة المشروعة مشروعة ايضا.
ان هذه النظرية تثير الكثير من القضايا، وقد اشار المؤلف الى بعضها، لان العمل (كالعمل السياسي) يصبح معيارا لتشخيص المشروعية في نظرية سقراط.
المشروعية والفاعلية
اما بخصوص مشروعية فاعلية الحكومة، اي «التركيبة التي تمكنها من تنفيذ اهدافها»، ففي الحكومة المشروعة على اساس العقد الاجتماعي يقول لاريجاني يكون قسم من بنية الحكومة على اساس العقد، ويصرح به في الدستور، فيما تقوم الدولة بايجاد القسم الآخر. اما في الحكومة القائمة على اصالة الوظيفة فالفاعلية تكون مطابقة لمصلحة «العمل »، ومن صلاحيات الحاكم. وبالمقارنة بين الحكومتين نجد ان الحكومة المبنية على اصالة الوظيفة مجبرة على عرض نظام حكومي لتحقيق اهدافها المتعلقة بكمال الانسان الذاتي، فمثلا «يكون لها نظام تشريعي وقانون ودستور، وللناس حق المشاركة في ابداء الرأي وهكذا، ولكن جميع هذه الامور هي من باب الفاعلية والكفاءة، وليست من باب المشروعية، وكذا الدستور فهو معيار المشروعية في النظام المبني على العقد الاجتماعي، اما في النظام السقراطي فهو من باب الفاعلية ».
وتظهر ملامح الاختلاف اكثر بين النظامين في ثلاث قضايا رئيسة عالجها المؤلف هي: طبيعة القانون، مكانة رأي الشعب، طبيعة العمل السياسي. القانون عند هوبز «هو الاطار الذي يجب على الحكومة ان تؤدي وظائفها من خلاله »، لذلك فاي خروج عنه يفقدها مشروعيتها. اما في نظام اصالة الوظيفة فالقانون هو اساس العمل، وهو من باب الفاعلية. لذلك يقول لاريجاني يمكننا القول: ان الوظيفة في النظام السقراطي «فوق القانون ».. من دون ان يعني ذلك ان لكل فرد الحق في ان يعمل ما يحلو له، فلا بد من القانون. وطاعة القانون هنا تكون من باب الوظيفة وليس من باب الوفاء بالعهد، «واذا كان الذي يحدد هذه الوظيفة هو المشرع سيكون الناس ملزمين «شرعا» بطاعتهم للقانون، وهو اقوى من قواعد الالزام الاخلاقية كالوفاء بالعهد.. وهنا نتساءل: من هو المشرع؟ ومن اين جاءت مشروعيته؟ في النظرية الاولى العقد الاجتماعي هو الذي يحدد الجهة التي ستقوم بالتشريع (مجلس النواب...)، اما في نظام اصالة الوظيفة فان مشروعية المشرع تنبع من اصالة الوظيفة، التي هي مصدر مشروعية الحكومة ايضا.
اما بخصوص رأي الشعب فهو، في النظرية الاولى، يتدخل من البابين معا المشروعية والفاعلية والكفاءة، فالشعب يعد مصدر اللافكار الجديدة بالاضافة الى مساعدته للحكومة ودعمه لها، لكن في اصالة الوظيفة ينحصر دوره فقط في باب الفاعلية والكفاءة، حيث نجد «الرأي المشروع هو الذي يرضى به الحاكم المشروع». اما القضية الثالثة، وهي العمل السياسي، فنظرية العقد لا تلزم الناس جميعهم باحتراف السياسة لانهم وكلوا من يقوم بذلك عنهم، بخلاف نظرية الاصالة، حيث السياسة كما يقول د. لاريجاني تملأ جوانب الحياة الانسانية، لان العمل السياسي هو اي عمل يقوم به الفرد في مسيرة الكمال، وبالتالي: «فالسياسة تعني الحياة الحقيقية للفرد»، انه يسعى بارادته الى العمل الصالح عن طريق الارتباط بالنظام السياسي الصالح.
طبعا لكل من النظامين مفاسد وآفات تهدده، فنظام اصالة الوظيفة قد يهدد بخطر الاستبداد، في الوقت الذي يسقط فيه نظام العقد في الفساد والعدمية، لذلك لا بد من الاهتمام بموضوع الفاعلية والكفاءة، وقد نال هذا الموضوع اهتمام علم السياسة. وهناك ثلاثة ابحاث اساسية في ما يتعلق بالفاعلية (القدرة) والكفاءة هي:
1ـ الدولة المبرمجة والدولة المدبرة (التي تحل المشاكل).
2ـ حرية الفرد والتنظيم.
3ـ الامن من المفاسد.
ومن خلال مناقشة هذه المحاور الرئيسة سيتم الكشف عن مختلف النظم الحكومية.
الى هنا انتهى المؤلف من عرض طبيعة النظامين في اطار مقارن مع ايراد الامثلة والتفريعات الكثيرة، ليصل بعد ذلك الى الحديث عن المشروعية العقلية للحكومة الاسلامية، بالاستناد الى هذه الاصول العامة العقلية في الفكر السياسي الغربي القديم والحديث، وحتى لا يقع اي التباس لدى القارى فالبحث هنا حول مصدر مشروعية الحكومة الاسلامية، وليس في بيان مشروعية اعمالها، لان الفقه الاسلامي يمكنه ان يقرر لكل عمل حكما خاصا به، هل هو حلال او حرام؟ لذلك فالبحث هنا كما يقول د. لاريجاني «في جذور شرعية النظام وليس في طبيعة قوانينه ».
لقد اختلف المفكرون الاسلاميون حول مصدر المشروعية، فمنهم من ارجعها للعقد الاجتماعي الذي ينص على اجراء الاحكام الاسلامية، ويرى د. لاريجاني ان الاخوان المسلمين في مصر ونهضة التحرير في ايران من القائلين بذلك، وهم متأثرون، في نظره، بالفكر السياسي الليبرالي، فيما يذهب المؤيدون لنظرية ولاية الفقيه الى اعتبار اصالة الوظيفة هي مصدر المشروعية، فالاسلام يرى ان للفرد كمالا ذاتيا، بل حدد الطريق الموصل الى هذا الكمال. ومن الناحية الفلسفية يقول د. لاريجاني تعد الكفاءة مصدر المشروعية، ولذلك فان اهمية اركان الدولة ومؤسساتها جميعها تأتي من كفاءة النظام وفاعليته، ومصدر مشروعيتها هو الولي، اي ان هناك من هو فوق القانون في حكومة ولاية الفقيه، وهذا لا يعني الفوضى في ادارة الدولة، لان ذلك مستحيل من ناحية الفاعلية والكفاءة.
وهذا الاشكال يمكن تجاوزه حسب المؤلف اذا ما تكفل الدستور ببيان اسس مشروعية النظام واسس فاعليته وكفاءته، لان الولي الفقيه سيتصرف دائما على اساس القانون، وقد حدد دستور الجمهورية الاسلامية اساس مشروعية النظام بالولاية المطلقة للفقيه، لذلك اذا ما اضطر الفقيه لمنع قانون ما من التنفيذ فسيكون عمله قانونيا؟! اما رأي الشعب فله مدخلية كبيرة ومهمة في باب كفاءة النظام وفاعليته، لان الولي الفقيه لا يمكنه «القيام بشي ء من دون رأي الناس ومشاركتهم».
طبعا هناك اسئلة كثيرة جدا يمكن ان تطرح، وهي بحاجة الى المزيد من التفصيل، لان المؤلف لم يعالجها واكتفى بالوصول الى هذه النتيجة، ثم انتقل لمعالجة قضية اخرى لا تقل اهمية، وهي البحث في اسس الفاعلية والكفاءة. ونلاحظ ان الاقتصار على تلخيص هذه النتيجة والاكتفاء بالمقارنات الكثيرة التي عقدها بين النظامين، لم يقدم صورة واضحة لعلاقة نظرية ولاية الفقيه باصالة الوظيفة، فهناك اسئلة حول وظيفة الفقيه نفسه وعلاقته بالقانون (النص والاجتهاد)، ومشروعية اجتهاده وسط اجتهادات اخرى؟! قد تكون هذه القضايا مفهومة بعض الشي ء داخل الوسط الشيعي الامامي الذي يعرف من اين يستمد الفقيه الامامي صلاحياته ومشروعية اجتهاده، لكن البحث هنا عقلي، وبالتالي قد يتجاوز الخصوصيات المذهبية ليشمل المدارس الفقهية الاخرى التي لم تتبلور لديها مثل هذه النظرية، وان كانت جذورها موجودة في التاريخ الاسلامي، فالخلفاء الراشدون كانوا فقهاء ومارسوا نوعا من الولاية الفقهية، وهناك سجال في مباحث الاصول حول قول الصحابي، ولا يقصد به في حقيقة الامر سوى اجتهاد الخلفاء الذين افتوا في الكثير من القضايا وشرعوا احكاما جديدة؟! لذلك فتوسيع البحث في هذه القضية يحررها من خصوصيتها المذهبية الشيعية، ويجعلها نظرية اسلامية عامة يمكن ان يفتح النقاش حولها داخل جميع المدارس الفكرية والفقهية الاسلامية. علاوة على الاتفاق شبه التام حول فكرة سعي المسلم نحو الكمال الذاتي، فالمسلمون قاطبة يؤمنون، ومن خلال تعاليم الرسالة الاسلامية وسيرة الرسول (ص)، بان الانسان المسلم هو انسان مهاجر كادح، ينشد الكمال عبر التزامه بتعاليم الرسالة التي تنقله من طور الى طور، في رحلة طويلة الى المطلق (الله سبحانه وتعالى)، مصداقا لقولنا: «انا للّه وانا اليه راجعون ». وكذلك الامة او المجتمع الاسلامي فهناك مفاهيم اساسية مثل: الجهاد (الذاتي والخارجي)، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الالتزام بالشريعة (التقوى)، تطبيق احكام الله (الدولة الاسلامية)، هذه المفاهيم جميعها تجعل من اصالة الوظيفة اساس مشروعية كل من المجتمع الاسلامي والحكومة.
الحكومة: اسس الفاعلية والكفاءة
اما بالنسبة لاسس الفاعلية والكفاءة فالبحث ينطلق من اعتبار الحكومة تجمعا عاملا وتنظيما اجتماعيا كاملا، والكفاءة فيه ترتبط بصدور الفعل من العامل، فكل فعل اكثر صحة (اكثر معقولية) «هو الاكفأ»، اذن فكفاءة الحكومة مرتبطة بطبيعة العمل المعقول او «العمل الصالح »، وهذا يجرنا للبحث في البنية العامة للعمل وما يتعلق بها من نقاط ذات صلة، كما يقول د. لاريجاني، بمسألة الصحة، او في الحقيقة بـ«الفاعلية ». لكن قبل الدخول في هذه المباحث لا بد من التأكيد ان المؤلف يرى ان لمفهوم العقلانية حول محور الكفاءة دورا محوريا في هذه البحوث النظرية، كما ان من الابعاد المذكورة دور الاسلام في طبيعة عمل الفرد او الجماعة، لذلك يرى المؤلف ان الاسلام ليس موضوعا زائدا على العقل «بل نعتقد ان العقل ينتهي بنا الى الاسلام »، وبهذا الشكل يصل الى كماله الحقيقي في جو الوحي، والعقل الذي نراه الاساس الوحيد في الهداية وتقييم العمل، هو الذي يعد من ثمار الشريعة المباركة، وهذا الامر، يقول د. لاريجاني، «لا يخل بالبنية الذاتية للعقل، بل يجعلها في موقعها الحقيقي والاصيل ». وبناء على ذلك «فالحكومة الاسلامية لا تسقط العقل على سلطته الاولى بل ترفعه الى مستواه الواقعي وتحكمه بقو ة في جميع الامور...».
عرض المؤلف مجموعة من النظريات الحديثة وهو يعالج اسس الكفاءة، وتحدث عن نظرية يقول انه طرحها، لاول مرة، سنة 1986، خلال محاضراته في جامعة طهران، يسميها:
«النظرية الذاتية للعمل »، ومن خلالها ينظر الى اركان العمل كالآتي:
1ـ في ما يتعلق بالفرد، فان فهم الوضع الحقيقي يكون على اساس المعرفة والمعلومات التي يملكها، اما في الحكومة فعلى اساس عقول متعددة وامكانيات علمية ومعلوماتية واسعة.
2ـ بالنسبة للوضع المنشود، فان قرار الفرد يكون على اساس القيم والدوافع التي يمتلكها، بينما عملية صنع القرار في الحكومة تعد عملية دقيقة ومبرمجة في ضوء الامكانيات والقدرات. 3ـ بالنسبة للبرنامج العملي الفردي، فان التخطيط له يكون على اساس التجارب الفردية، بينما البرنامج العملي للدولة يكون بمشاركة جميع الاجهزة، وعلى اساس استراتيجية معدة سلفا في اطار القوانين، وهدفها تحقيق الوضع المنشود...
ومن خلال الصورة التي نمتلكها عن طبيعة العمل الارادي نكتشف لوازم فاعلية الحكومة وكفاءتها...
والخلاصة فمسألة كفاءة الحكومة مرتبطة بالاركان الاساسية لعمل الحكومة اي:
1ـفهم الوضع الحقيقي، 2ـ اختيار الوضع المنشود، 3ـ كيفية التخطيط لبرنامج العمل وتنفيذه.
وقد عالج المؤلف قضايا مرتبطة بهذه المفاهيم لانها تتعلق بالبحث العام في اسس فاعلية اي نظام، مثل دور الخبرة والتخصص، البرمجة، صناعة القرار.
ذلك كله في اطار بحث مقارن بين مجموعة من النظريات حول الكفاءة، مثل نظرية محورية العمل والنظرية العملية للكفاءة، وقد ادى ذلك لبحث نظرية العالم الالماني المشهور ماكس فيبر حول العمل الارادي لانها في صلب الحديث عن الكفاءة، كما ناقش مفهوم العقلانية لانه يستخدم كثيرا في مباحث المشروعية والكفاءة عندما يتم الحديث عن «حكومة العقل »، «العمل العقلاني » و«التفسير العقلاني ». ومباحث العقلانية تثير بدورها الكثير من الاشكاليات المهمة، اهمها:
العلاقة بين العقلانية والدين، لان تقييم عقلانية عمل المسلم تكون على اساس الشريعة الاسلامية وليس على اساس اي قانون آخر؟ وعليه: «كيف يمكن تقييم عقيدة ما عقلانيا؟!» خصوصا مع ادخال العقيدة في عملية التقييم العقلاني؟ ان العقيدة تقدم معنى للوجود وتحدد مكانة الانسان فيه، ما يجعله على علم بمفهوم السعادة والكمال، وهذه الاسئلة من اختصاص الحكمة الاولى (اي الفلسفة)، وهنا يكمن المأزق الذي سقطت فيه الليبرالية التي تجاوزت هذه الاسئلة الوجودية، مع ان العمل العقلاني لا بد من ان يستند الى عقيدة او ايديولوجية ما؟ واذا ما حذفنا العقيدة في عملية تقويم عقلانية اي عمل ما نكون امام «العقل التقني » في مقابل «العقل الاصيل » الذي يستند الى العقيدة، وهذا ما وصلت اليه الليبرالية الذي ينحصر مفهوم عقلانية العمل لديها في النجاح واعتبار امكانية العمل فقط؟! وهذه العقلانية التقنية المحدودة هي التي تؤسس للتعددية والنسبية في جميع المجالات، وهنا سنكون بحاجة الى تقويم ونقد لاسس الحداثة الغربية، وهذا ما قام به المؤلف من خلال هذه المباحث، حول المشروعية والكفاءة، مستشهدا بعدد من الاقوال لفلاسفة الغرب توصلوا للنتيجة نفسها في نقدهم لليبرالية الديمقراطية، مثل الفيلسوف الالماني ماكس فيبر الذي يرى ان الامريكيين وضعوا انفسهم في قفص حديدي فاسد لقوم انقطعوا عن جذورهم تماما، ولهذا فنهايتهم واضحة: فاما ان يتحلل نظامهم (مع المجتمع) بشكل آلي، او يقع تحت سيطرة اخصائيين فاقدين لاية معنوية او روح، او يبلون بديانات وبدع خطرة ليواجهوا بها الثغرات الموجودة.
العقلانية الاصيلة والنظام الحقاني
في الحقيقة لا تمكن الاشارة الى جميع القضايا التي تناولها المؤلف، لانها متشعبة ومترابطة، ما يجعل من الصعوبة الحديث عن اي قضية من دون تتبع تسلسلها في البحث، لذلك اكتفينا بالاشارة الى امهات المسائل التي توصل اليها المؤلف، الذي بعد ان قدم تصوره لحكومة العقل، ربط بين العقل والعقيدة، معتبرا ان اي عمل لا يستند الى عقيدة لا يمكن ان يكون عقلانيا اصيلا وانما عقلانيته ستكون تقنية. اما بخصوص عقلانية العقيدة فترتبط بالحقانية، فعندما نصل الى حقانية اي عقيدة نكون امام مطابقتها للعقلانية تماما ، ومن ثم فجميع الافعال والاعمال التي تستند الى هذه العقيدة هي عقلانية، وبذلك يعيد المؤلف البحث في الجذور، ويوجه النقد القاسي الى الحداثة الغربية التي قفزت على هذه الجذور عندما عجزت عن الوصول الى حقانية العقيدة والدين من خلال مباحث الوجود في الفلسفة. والبحث في الجذور يتجاوز البحث والنقاش، وهي اشكالية مهمة لان الحق، كما يقول المؤلف، هو الامر المفقود بالنسبة للبشر، والحق نقطة اتصال الفكر بالعمل.
ان النظام الاجتماعي المبني على الدين، وحسب الفكر الغربي، هو نظام غير عقلاني، وذلك انطلاقا من مفهومي الدين والتدين واعتبارهما من الظواهر الاجتماعية ذات الجذور التاريخية التي يمكن ان تخضع للبحث والتحليل لاكتشاف عللها، لكن الفكر الغربي لم يهتم بحقانية الدين وصحته، لذلك فامكانية حقانية الدين، يقول لاريجاني، «تمكن مباشرة من امكانية البناء العقلاني للنظام الاجتماعي على اساس الدين »، لان الدين الصحيح هو دين عقلاني، كما ان فكر الحداثة اذا لم يكن صحيحا فهو بالضرورة غير عقلاني، وهذه معادلة منطقية.
واهم ما يلاحظ، في عرض المؤلف لهذه المباحث، ومناقشاته للفكر السياسي الغربي، وحديثه عن الاسلام والتدين الصحيح واهمية الاستناد الى العقيدة الصحيحة لكي تكون الاعمال صحيحة ومشروعة وعقلانية، هو ان مجمل الافكار والاسئلة والمقترحات يمكن ان توجه للحكومة الاسلامية، اولا:
لتستفيد منها في المجالين النظري (التأصيلي) والعملي (مواجهة التحديات الواقعية). ثانيا: هناك الكثير من الافكار النقدية الموجهة لهذه الحكومة خصوصا في ما يتعلق بكفاءتها وتعاطيها مع الشأن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيقها للاهداف التي اعلنتها، وكان د. لاريجاني، من خلال بحوثه النظرية العميقة، يريد ان يقدم برنامجا سياسيا لعمل الحكومة الاسلامية، ويوجهها للطريق القويم (العقلاني الواقعي)، الذي يجب ان تسلكه، لكن عن طريق البحث الفلسفي الرصين، وليس عبر الخطابات السياسية، وهذا يذكرنا ببعض الادبيات السياسية الاسلامية القديمة.
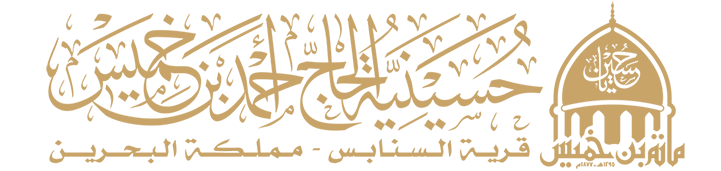



التعليقات (0)