حينما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلّف أمة ومجتمعا ودولة. وأقصد بالأمة المجموعة من المسلمين الذين كانوا يؤمنون برسالته ويعتقدون بنبوته واقصد بالمجتمع تلك المجموعة من الناس التي كانت تمارس حياتها على أساس تلك الرسالة وتنشئ علاقاتها على أساس التنظيم المقرر لهذه الرسالة وأقصد بالدولة القيادة التي كانت تتولى، تزعم التجربة في ذلك المجتمع، والاشتغال على تطبيق الإسلام وحمايته مما يهدده من أخطار وإنحراف.
الإنحراف الذي حصل يوم السقيفة، كان أول ما كان في كيان الدولة، لأن القيادة كانت قد اتخذت طريقاً غير طريقها الطبيعي، وقلنا بأن هذا الإنحراف الذي حصل يوم السقيفة، في زعامة التجربة أي الدولة، كان من الطبيعي في منطق الاحداث أن ينمو ويتسع، حتى يحيط بالتجربة نفسها، فتنهار الزعامة التي تشرف على تطبيق الإسلام.
هذه الزعامة باعتبار إنحرافها، وعدم كونها قادرة على تحمل المسؤولية، تنهار في حياتها العسكرية والسياسية، وحينما تنهار الدولة، حينما تنهار زعامة التجربة ينهار تبعاً لذلك المجتمع الإسلامي، لأنه يتقوم بالعلاقات التي تنشأ على أساس الإسلام، فاذا لم تبق زعامة التجربة لترعى هذه العلاقات وتحمي وتقنن قوانين لهذه العلاقات، فلا محالة ستتفتت هذه العلاقات، وتتبدل بعلاقات اُخرى قائمة على أساس آخر غير الإسلام، وهذا معناه زوال المجتمع الإسلامي.
تبقى الإمة بعد هذا وهي أبطأ العناصر الثلاثة تصدعاً وزوالاً، بعد أن زالت الدولة الشرعية الصحيحة، وزال المجتمع الإسلامي الصحيح، تبقى الأمة، إلا أن هذه أيضاً من المحتوم عليها أن تتفتت، وأن تنهار، وأن تنصهر ببوتقة الغزو الكافر، الذي أطاح بدولتها ومجتمعها. لأن الأمة التي عاشت الإسلام زمناً قصيراً، لم تستطع أن تستوعب من الإسلام ما يحصنها، ما يحدد أبعادها ما يقويها، ما يعطيها أصالتها وشخصيتها وروحها العامة وقدرتها على الاجتماع على مقاومة التميع والتسيب والانصهار في البوتقات الأخرى.
هذه الأمة بحكم أن الإنحراف قصّر عمر التجربة، وبحكم أن الإنحراف زوّر معالم الإسلام، بحكم هذين السببين الكمي والكيفي، الأمة غير مستوعبة، الأمة تتحصّن بالطاقات التي تمنعها وتحفظها عن الإنهيار أمام الكافرين وأمام ثقافات الكافرين، فتتنازل بالتدريج، عن عقيدتها عن آدابها، عن أهدافها وعن أحكامها، ويخرج الناس من دين اللّه أفواجاً، وهذا ما أشارت إليه رواية عن أحد الأئمة (عليهم السلام) يقول فيها بأن أول ما يتعطل من الإسلام هو الحكم بما أنزل اللّه سبحانه وتعالى، وآخر ما يتعطل من الإسلام هو الصلاة، هذا هو تعبير بسيط عما قلناه من إن أول ما يتعطل هو الحكم بما أنزل اللّه أي إن الزعامة والقيادة للدولة تنحرف، وبإنحرافها سوف يتعطل الحكم بما أنزل اللّه. وهذا الخط ينتهي حتماً إلى أن تتعطل الصلاة، يعني إلى تمييع الأمة، تعطل الصلاة هو مرحلة أن الأمة تتعطل، إن الأمة تتنازل عن عقيدتها، إن الأمة تضيع عليها رسالتها وآدابها وتعاليمها.
الحكم بغير ما أنزل اللّه، معناه إن التجربة تنحرف، إن المجتمع يتميّع... في مقابل هذا المنطق وقف الأئمة (عليهم السلام) على خطين:
الخط الأول: هو خط محاولة تسلم زمام التجربة، زمام الدولة، محو آثار الإنحراف، إرجاع القيادة إلى موضعها الطبيعي لأجل أن تكتمل العناصر الثلاثة: الأمة والمجتمع والدولة.
الخط الثاني: الذي عمل عليه الأئمة (عليهم السلام)، هو خط تحصين الأمة ضد الإنهيار، بعد سقوط التجربة واعطائها من المقومات، القدر الكافي، لكي تبقى وتقف على قدميها، وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة، بقدم راسخة وروح مجاهدة، وبإيمان ثابت.
والآن، نريد أن نتبين هذين الخطين في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام)، مع استلال العبر في المشي على هذين الخطين.
على الخط الأول خط محاولة تصحيح الإنحراف وإرجاع الوضع الاجتماعي والدولي في الأمة الإسلامية إلى خطه الطبيعي، في هذا الخط، عمل (عليه السلام) حتى قيل عن الإمام علي (عليه السلام) أنه أشد الناس رغبة في الحكم والولاية، أتهمه معاوية بن أبي سفيان، بأنه طالب جاه، وأنه طالب سلطان. أتهمه بالحقد على أبي بكر وعمر، أتهمه بكل ما يمكن أن يتهم الشخص المطالب بالجاه وبالسلطان وبالزعامة.
أمير المؤمنين (عليه السلام) عمل على هذا الخط خط تسلم زمام الحكم، وتفتيت هذا الإنحراف، وكسب الزعامة زعامة التجربة الإسلامية إلى شخصه الكريم، بدأ هذا العمل عقيب وفاة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) مباشرة، حيث حاول إيجاد تعبئة وتوعية فكرية عامة في صفوف المؤمنين وإشعارهم بأن الوضع وضع منحرف.
إلا أن هذه التعبئة لم تنجح لأسباب ترتبط بشخص الإمام علي (عليه السلام)، ولأسباب أخرى ترتبط بإنخفاض وعي المسلمين أنفسهم. لأن المسلمين وقتئذ لم يدركوا أن يوم السقيفة كان هو اليوم الذي سوف ينفتح منه كل ما انفتح من بلاء على الخط الطويل لرسالة الإسلام، لم يدركوا هذا، ورأوا إن وجوهاً ظاهرة الصلاح قد تصدّت لزعامة المسلمين ولقياداتهم في هذا المجال، ومن الممكن خلال هذه القيادة، أن ينمو الإسلام وأن تنمو الأمة.
لم يكن يفهم من الإمام علي (عليه السلام) إلا أن له حقاً شخصياً يطالب به، وهو مقصر في مطالبته، إلا أن المسألة لم تقف عند هذا الحد، فضاقت القصة على أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذه الناحية، ومن أننا نجد في مراحل متأخرة من حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) المظاهر الأخرى لعمله على هذا الخط، لمحاولة تسلمه أو سعيه في سبيل تسلم زعامة التجربة الإسلامية وتفادي الإنحراف الذي وقع، إلا أن الشيء الذي هو في غاية الوضح، من حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه (عليه السلام) في عمله في سبيل تزعم التجربة، وفي سبيل محاربة الإنحراف القائم ومواجهته بالقول الحق وبالعمل الحق، وبشرعية حقه في هذا المجال، كان يواجه مشكلة كبيرة جداً، وقد استطاع أن ينتصر على هذه المشكلة إنتصاراً كبيراً جداً أيضاً.
هذه المشكلة التي كان يواجهها هي مشكلة الوجه الظاهري لهذا العمل والوجه الواقعي لهذه العمل.
قد يتبادر إلى ذهن الإنسان الاعتيادي لأول مرة إن العمل في سبيل معارضة زعامة العصر، والعمل في سبيل كسب هذه الزعامة، إنه عمل في إطار فكري، إنه عمل يعبَّر عن شعور هذا العامل بوجوده، وفي مصالحه، وفي مكاسبه، وبأبعاد شخصيته، هذا هو التفسير التلقائي الذي يتبادر إلى الأذهان، من عمل يتمثل فيه الإصرار على معارضته في زعامة العصر على كسب هذه الزعامة، وقد حاول معاوية كما أشرنا أن يستغل هذه البداهة التقليدية في مثل هذا الموقف من أمير المؤمنين (عليه السلام).
إلا أن الوجه الواقعي لهذا العمل من قبل الإمام (عليه السلام) لم يكن هذا، الوجه الواقعي هو أن علياً كان يمثل الرسالة وكان هو الأمين الأول من قبل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)على التجربة على استقامتها وصلابتها، وعدم تميعها على الخط الطويل، الذي سوف يعيشه الإسلام والمسلمون بعد النبي (صلى الله عليه وآله). فالعمل كان بروح الرسالة ولم يكن بروحه هو، كان عملاً بروح تلك الأهداف الكبيرة، ولم يكن عملاً بروح المصلحة الشخصية، لم يكن يريد أن يبني زعامة لنفسه، وإنما كان يريد أن يبني زعامة الإسلام وقيادة الإسلام في المجتمع الإسلامي، وبالتالي في مجموع البشرية على وجه الأرض.
هذان وجهان مختلفان، قد يتعارضا في العامل نفسه، وقد يتعارضان في نفس الأشخاص الآخرين، الذين يريدون أن يفسروا عمل هذا العامل.
هذا العامل قد يتراءى له في لحظة انه يريد أن يبني زعامة الإسلام لا زعامة نفسه، إلا أنه خلال العمل، إذا لم يكن مزوداً بوعي كامل. إذا لم يكن مزوداً بإرادة قوية، إذا لم يكن قد استحضر في كل لحظاته وآنات حياته، إنه يعيش هذه الرسالة ولا يعيش نفسه، إذا لم يكن هكذا، فسوف يحصل في نفسه ولولا شعوريا انفصام بين الوجه الظاهري للعمل وبين الوجه الحقيقي للعمل، وبمثل هذا الإنفصام سوف تضيع أمامه كل الاهداف أو جزء كبير من تلك الاهداف سوف ينسى إنه لا يعمل لنفسه بل هو يعمل لتلك الرسالة سوف ينسى إنه ملك غيره وإنه ليس ملكاً لنفسه: كل شخص يحمل هذه الاهداف الكبيرة، يواجه خطر الضياع في نفسه، وخطر أن تنتصر أنانيته على هذه الاهداف الكبيرة، فيسقط في أثناء الخط، يسقط في وسط الطريق، وهذا ما كان الإمام علي (عليه السلام) معه على طرفي نقيض. الإمام علي (عليه السلام) كان يصّر دائماً على أن يكون زعيماً، يصّر دائماً على أن يكون هو الأحق بالزعامة، الإمام علي الذي يتألم، الذي يتحسّر إنه لم يصبح زعيماً بعد محمد (صلى الله عليه وآله) الذي يقول: لقد تقصمها ابن ابي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، في غمرة هذا الألم، في غمرة هذه الحساسية، يجب أن لا ننسى أن هذا الألم ليس لنفسه، إن هذه الحساسية ليست لنفسه، إن كل هذا العمل وكل هذا الجهد، ليس لأجل نفسه بل من أجل الإسلام. وكذلك كان يربي أصحابه على أنهم أصحاب تلك الاهداف الكبيرة، لا أصحاب زعامته وشخصه، وقد انتصر الإمام علي (عليه السلام) انتصاراً عظيماً في كلتا الناحيتين.
انتصر الإمام على نفسه، وانتصر في إعطاء عمله إطاره الرسالي وطابعه العقائدي انتصاراً كبيراً.
الإمام علي ربي أصحابه على أنهم أصحاب الأهداف لا أصحاب نفسه. كان يدعو إلى أن الإنسان يجب أن يكون صاحب الحق، قبل أن يكون صاحب شخص بعينه. الإمام علي هو الذي قال: (اعرف الحق تعرف أهله) كان يربي أصحابه، يربى عماراً وأبا ذرّ والمقداد على أنكم اعرفوا الحق... ثم احكموا على علي (عليه السلام) في إطار الحق. وهذا غاية ما يمكن أن يقدمه الزعيم من إخلاص في سبيل أهدافه. أن يؤكد دائماً لأصحابه وأعوانه - وهذا مما يجب على كل المخلصين - إن المقياس هو الحق وليس هو الشخص. إن المقياس هو الأهداف وليس هو الفرد.
هل يوجد هناك شخص أعظم من الإمام علي بن ابي طالب. لا يوجد هناك شخص اعظم من الإمام علي إلا أستاذه، لكن مع هذا جعل المقياس هو الحق لا نفسه.
لما جاءه ذلك الشخص وسأله عن الحق في حرب الجمل هل هو مع هذا الجيش أو مع ذلك الجيش، كان يعيش في حالة تردد بين عائشة وعلي، يريد أن يوازن بين عائشة وعلي، أيهما أفضل حتى يحكم بأنه هو مع الحق أو عائشة. جهودها للإسلام أفضل أو جهود علي أفضل، قال له: اعرف الحق تعرف اهله.
الإمام علي كان دائماً مصرّاً على أن يعطي العمل الشخصي طابعه الرسالي، لا طابع المكاسب الشخصية بالنسبة إليه، وهذا هو الذي يفّسر لنا كيف إن علياً (عليه السلام)، بعد أن فشل في تعبئته الفكرية عقيب وفاة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، لم يعارض ابا بكر وعمر معارضة واضحة سافرة طيلة حياة ابي بكر وعمر، وذلك إن أول موقف اعتزل فيه الإمام علي المعارضة بعد تلك التعبئة الفكرية واعطائها شكلاً واضحاً صريحاً كان عقيب وفاة عمر، يوم الشورى حينما خالف ابا بكر وعمر، هذا عندما حاول عبد الرحمن بن عوف حينما اقترح عليه المبايعة أن يبايعه على كتاب اللّه وسنة رسول وسنة الشيخين، قال (عليه السلام): بل على كتاب اللّه وسنة نبيه واجتهادي. هنا فقط اعلن عن معارضة عمر، في حياة أبي بكر وعمر بعد تلك التعبئة، لم يبد موقفاً إيجابياً واضحاً في معارضتهما، والوجه في هذا، هو أن علياً (عليه السلام) كان يريد ان تكون المعارضة في إطارها الرسالي، وأن ينعكس هذا الإطار على المسلمين، أن يفهموا أن المعارضة ليست لنفسه، وإنما هي للرسالة، وحيث أن أبا بكر وعمر كانا قد بدآ الإنحراف، ولكن الإنحراف لم يكن قد تعمق بعد والمسلمون قصيرو النظر، الذين قدموا أبا بكر على الإمام علي (عليه السلام) ثم قدموا عمر على أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، هؤلاء المسلمون القصيرو النظر لم يكونوا يستطيعون أن يعمقوا النظر إلى هذه الجذور، التي نشأت في أيام أبي بكر وعمر فكان معنى مواصلة المعارضة بشكل جديد أن يفسر من أكثر المسلمين، بأنه عمل شخصي، وإنها منافسة شخصية مع أبي بكر وعمر وأن بدأت بهم بذور الإنحراف في عهدهما إلا أنه حتى هذه البذور كانت الاغلب مصبوغة بالصبغة الإيمانية، كانا يربطانها بالحرارة الإيمانية الموجودة عند الأمة، وحيث إنها حرارة إيمانية بلا وعي، ولهذا لم تكن الأمة تميز هذا الإنحراف.
عمر ميز بين الطبقات، إلا أنه حينما ميز بين الطبقات، حينما أثرى قبيلة بعينها دون غيرها من القبائل؟! أتعرفون أي قبيلة هي التي اثراها، هي قبيلة النبي (صلى الله عليه وآله)، عمر أغنى قبيلة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) اغنى عم محمد (صلى الله عليه وآله) اعطى زوجات النبي عشرة آلاف، كان يعطي للعباس اثني عشر ألفا، كان يقسم الأموال الضخمة على هذه الأسرة، هذا الإنحراف لا يختلف في جوهره عن إنحراف عثمان بعد ذلك، عثمان حينما ميز، إلا أن عمر فقط ربط هذا الإنحراف بالحرارة الإيمانية عند الإمة، لأن الحرارة الإيمانية عند الأمة كانت تقبل مثل هذا الإنحراف. هؤلاء أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله)، هذا عم النبي (صلى الله عليه وآله)، هذه زوجة النبي (صلى الله عليه وآله)، إذن هؤلاء يمكن ان يعطوا يمكن أن يثروا على حساب النبي (صلى الله عليه وآله)، لكن عثمان حينما جاء لم يرد على هذا الإنحراف شيئاً، إلا أنه لم يرتبط بالحرارة الإيمانية، بدّل عشيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعشيرته هو، وهذا أيضاً إنحراف مستمر لذلك الإنحراف، إلا أنه إنحراف مكشوف. ذاك إنحراف مقنّع، ذاك إنحراف مرتبط بالحرارة الإيمانية عند الأمة، وهذا إنحراف يتحدى مصالح الأمة، والمصالح الشخصية للأمة، ولهذا استطاعت الأمة أن تلتفت إلى إنحراف عثمان بينما لم تلتفت بوضوح إلى إنحراف أبي بكر وعمر، وبهذا بدأ الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) معارضته لأبي بكر وعمر في الحكم بشكل واضح، بعد أن مات أبو بكر وعمر، لم يكن من المعقول تفسير هذه المعارضة على إنها معارضة شخصية بسبب طمع في سلطان، بدأ هذه المعارضة وأعطى رأيه بأبي بكر وعمر.
علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد أن تم الأمر لعثمان، بعد أن بويع عثمان يوم الشورى، قال: أن سوف اسكت ما سلمت مصالح المسلمين وأمور المسلمين، وما دام الغبن علي وحدي، وما دمت أنا المظلوم وحدي، وما دام حقي هو الضائع وحدي. أنا سوف اسكت سوف أبايع سوف أطيع عثمان، هذا هو الشعار الذي أعطاه بصراحة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وبهذا الشعار أصبح في عمله رسالياً، وأنعكست هذه الرسالة على عهد أمير المؤمنين، وبقي (عليه السلام) ملتزماً بما تعهّد به من السكوت إلى أن بدأ الإنحراف في حياة عثمان بشكل مفضوح، حيث لم يرتبط بلون من ألوان الحرارة الإيمانية التي أرتبط بها الإنحراف في أيام الخليفة الأول وفي أيام الخليفة الثاني، بل أسفر الإنحراف، ولهذا أسفر الإمام علي (عليه السلام) عن المعارضة وواجه عثمان بما سوف نتحدث عنه بعد ذلك.
فالإمام علي (عليه السلام) في محاولته لتسلم زمام التجربة وزعامة القضية الإسلامية كان يريد أن يوفق بين هذا الوجه الظاهري للعمل، وبين الوجه الواقعي للعمل، وأستطاع أن يوفق بينهما توفيقاً كاملاً، استطاع هذا في توقيت العمل، واستطاع هذا في تربيته لأصحابه، على أنهم أصحاب الأهداف لا أصحاب الأشخاص، واستطاع في كل هذه الشعارات التي طرحها، أن يثبت أنه بالرغم من كونه في قمة الرغبة لأن يصبح حاكماً، لم يكن مستعداً أبداً لان يصبح حاكماً مع اختيار أي شرط من الشروط المطلوبة التي تنال من تلك الرسالة.
ألم تعرض عليه الحاكمية والرسالة بعد موت عمر بشرط أن يسير سيرته؟ فرفض الحاكمية برفض هذا الشرط.
علي بن ابي طالب (عليه السلام) بالرغم من أنه كان في أشد ما يكون سعياً وراء الحكم، جاءه المسلمون بعد أن قتل عثمان، عرضوا عليه أن يكون حاكماً، قال لهم بايعوا غيري وأنا أكون كأحدكم، بل أكون أطوعكم لهذا الحاكم، الذي تبايعونه، ما سلمت أمور المسلمين في عدله وعمله، يقول ذلك، لأن الحقد الذي تواجهه الأمة الإسلامية كبير جداً، تتمادى بذرة الإنحراف، الذي عاشه المسلمون بعد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قتل عثمان، هذا الإنحراف الذي تعمق، الذي أرتفع، هذا الإنحراف الذي طغى والذي استكبر، الذي خلق تناقضات في الأمة الإسلامية، هذا عبء كبير جداً.
ماذا يريد أن يقول، يريد أن يقول: لأني أنا لا أقبل شيئاً إلا على أن تصفّوا الإنحراف، أنا لا أقبل الحكم الذي لا يصفي هذا الإنحراف لا الحكم الذي يصفّيه، هذه الاحجامات عن قبول الحكم في مثل هذه اللحظات كانت تؤكد الطابع الرسالي، بحرقته بلوعته، لألمه لرغبته أن يكون حاكماً، استطاع أن ينتصر على نفسه، ويعيش دائماً لأهدافه، واستطاع أن يربي أصحابه أيضاً على هذا المنوال. هذا هو الخط الأول وهو خط محاولة تسلمه لزمام التجربة الاسلامية.
أما على الخط الثاني:
وهو خط تحصين الأمة لقد كانت الأمة تواجه خطراً، وحاصل هذا الخطر هو أن العامل الكمي والعامل الكيفي، سوف يجعلان هذه الأمة لا تعيش الإسلام، إلا زمنا قصيراً.
بحكم العامل الكمي الذي سوف يسرع، في إفناء التجربة وسوف لن تعيش إلا مشوهة بحكم العامل الكيفي، الذي يتحكم في هذه التجربة، ولذا بدأ الإمام بتحصين الأمة، وبالتغلب على العاملين: العامل الكمي والعامل الكيفي.
أما التغلب على العامل الكمي فكان في محاولة تحطيم التجربة المنحرفة وتحجيمها وإفساح المجال للتجربة الإسلامية لتثبت جدارتها وذلك بأسلوبين:
الإسلوب الأول: هو التدخل الإيجابي الموجه في حياة هذه التجربة بلحاظ قيادتها.
القادة والزعماء الذين كانوا يتولون هذه التجربة، كانوا يواجهون قضايا كثيرة لا يحسنون مواجهتها، كان يواجههم مشاكل كثيرة لا يحسنون حلّها، ولو حاولوا لوقعوا في أشد الأضرار والأخطار، لأوقعوا المسلمين في أشد التناقضات، ولأصبحت النتيجة محتومة أكثر، ولأصبحت التجربة أقرب إلى الموت، وأقرب إلى الفناء وأسرع إلى الهلاك، هنا كان يتدخل الإمام (عليه السلام) وهذا خط عام سار الأئمة (عليهم السلام) كلهم عليه كما قلنا، كما سوف نقول، فكان الإمام (عليه السلام) يتدخل تدخلاً إيجابياً، موجهاً في سبيل أن ينقذ التجربة من المزيد من الضياع ومن المزيد من الإنحراف، ومن المزيد من السير في الضلال.
كلنا نعلم، بأن المشاكل العقائدية التي كانت تواجهه (عليه السلام) والزعامة السياسية بعد النبي (صلى الله عليه وآله). هذه المشاكل العقائدية التي كان يثيرها، وتثيرها القضايا الأخرى التي بدأت تندرج في الأمة الإسلامية والأديان الأخرى التي بدأت تعاشر المسلمين، هذه المشاكل العقائدية لم تكن الزعامات السياسية وقتئذ على مستوى حلها كان الإمام (عليه السلام) يعين تلك الزعامات في التغلب على تلك المشاكل العقائدية.
كلنا نعلم بأن الدولة الإسلامية واجهت في عهد عمر خطراً من أعظم الأخطار، خطر إقامة إقطاع لا نظير له في المجتمع الإسلامي، كان من المفروض أن يسرع في دمار الأمة الإسلامية، وذلك حينما وقع البحث بين المسلمين بعد فتح العراق، في أنه هل توزع أراضي العراق على المجاهدين المقاتلين، أو أنها تبقى ملكاً عاماً للمسلمين، وكان هناك إتجاه كبير بينهم إلى أن توزع الأراضي على المجاهدين الذين ذهبوا إلى العراق وفتحوا العراق، وكان معنى هذا أن يعطى جميع العالم الإسلامي، أي يعطي العراق، وسوريا وإيران ومصر وجميع العالم الإسلامي الذي أسلم بالفتح، سوف يوزع بين أربعة أو خمسة آلاف أو ستة الآف من هؤلاء المسلمين المجاهدين، سوف تستقطع أراضي العالم الإسلامي لهؤلاء، وبالتالي يتشكل إقطاع لانظير له في التاريخ.
هذا الخطر الذي كان يهدد الدولة الإسلامية، وبقي عمر لاجل ذلك أياماً متحيراً لأنه لا يعرف ماذا يصنع، لا يعرف ما هو الأصلح، وكيف يمكن أن يعالج هذه المشكلة.
علي بن ابي طالب (عليه السلام) هو الذي تدخل كما تعلمون وحسم الخلاف، وبيّن وجهة النظر الإسلامية في الموضوع، وأخذ عمر بنظر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وانقذ بذلك الإسلام من الدمار الكبير.
وكذلك له تدخلات كبيرة وكثيرة، النفير العام الذي اقترح على عمر والذي كان يهدد العاصمة في غزو سافر، كان من الممكن أن يقضي على الدولة الإسلامية، هذا الاقتراح طرح على عمر، كاد عمر أن يأخذ به، جاء الإمام علي (عليه السلام) إلى المسجد مسرعاً على ما أتذكر في بعض الروايات تقول: جاء مسرعاً إلى عمر، قال له: لا تنفر نفيراً عاماً، كان عمر يريد أن يخرج مع تمام المسلمين الموجودين آنذاك في المدينة، وعندما تفرغ عاصمة الإسلام ممن يحميها من غزو المشركين والكافرين، منعه من النفير العام.
وهكذا كان الإمام علي (عليه السلام) يتدخل تدخلاً إيجابياً موجهاً في سبيل أن يقاوم المزيد من الإنحراف، والمزيد من الضياع، كي يطيل عمر التجربة الإسلامية ويقاوم عامل الكم الذي ذكرناه. هذا أحد أسلوبي مقاومة العامل الكمي.
الاسلوب الثاني: لمقاومة العامل الكمي كان هو المعارضة. يعني كان تهديد الحكام ومنعهم من المزيد من الإنحراف، لا عن سبيل التوجيه، وإنما عن سبيل المعارضة والتهديد.
في الأول كنا نفرض أن الحاكم فارغ دينياً، وكان يحتاج إلى توجيه، والإمام (عليه السلام) كان يأتي ويوجه، أما الأسلوب الثاني، فيكون الحاكم فيه منحرفاً ولا يقبل التوجيه، أذن فيحتاج إلى معارضة، يحتاج إلى حملة ضد الحاكم هذا، لاجل إيقافه عند حده، ولاجل منعه من المزيد من الإنحراف. وكانت هذه هي السياسة العامة للأئمة (عليهم السلام).
ألسنا نعلم بأن عمر صعد على المنبر وقال: ماذا كنتم تعملون لو أنا صرفناكم عما تعلمون إلى ما تنكرون.
كان يريد أن يقدر الموقف.
وماذا سيكون لو أنا صرفناكم مما تعلمون إلى ما تنكرون.
لو أنحرفنا شيئاً قليلاً عن خط الرسالة ماذا سيكون الموقف.
لم يقم له إلا الإمام علي (عليه السلام) قال له: لو فعلت ذلك لعدّلناك بسيوفنا.
كان هذا هو الشعار العام للإمام (عليه السلام) بالرغم من إنه لم يتنزل في عملية تعديل عمر بالسيف خلال حكم عمر، لظروف ذكرناها، إلا أنه قاد المعارضة لعثمان، واستقطب آمال المسلمين ومشاعر المسلمين، واتجاهات المسلمين، نحو حكم صحيح، ولهذا كان هو المرشح الأساسي بعد أن فشل عثمان، واجتمع عليه المسلمون.
الإمام علي (عليه السلام) يتصدى للمعارضة لاجل أن يوقف الإنحراف:
هذان اسلوبان كانا هما الاسلوبان المتبعان لمواجهة العامل الجديد. ثم هذه المعارضة نفسها كانت تعبر من ناحية أخرى عن الخط الثاني، وهو المحافظة على الأمة الإسلامية من الإنهيار بعد سقوط التجربة حيث أن المسلمين لم يعيشوا التجربة الصحيحة للإسلام، أو بعدوا عنها، والتوجيه وحده لا يكفي، لأن هذا العمل لا يكفي لأن يكسب مناعة. المناعة الحقيقية والحرارة الحقيقية للبقاء والصمود كأمة، إذن كان لا بد من أن يحدد الموقف. من أن يحدد الوجه الحقيقي للإسلام، في سبيل الحفاظ على الإسلام، وهذا الوجه الحقيقي للإسلام قدمه الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) من خلال معارضته للزعامات المنحرفة أولاً، ومن خلال حكم الإمام بعد أن مارس الحكم بنفسه.
من خلال هذين العملين، ومن خلال العمل السياسي المتمثل في المعارضة، والعمل السياسي المتمثل في رئاسة الدولة بصورة مباشرة، قدم الوجه الحقيقي للإسلام، الاطروحة الصحيحة للحياة الإسلامية الاطروحة الخالية من كل تلك الألوان من الإِنحراف.
طبعاً هذا لا يحتاج إلى حديث، ولا يحتاج إلى تمثيل لأنه واضح لديكم.
أمير المؤمنين حينما تولى الحكم، لم يكن يستهدف من تولي الحكم تحصين التجربة أو الدولة، بقدر ما كان يستهدف تقديم المثل الأعلى للإسلام، لأنه كان يعرف إن التناقضات، في الأمة الإسلامية، بلغت إلى درجة لا يمكن معها أن ينجح عمل إصلاحي أزاء هذا الإنحراف مع علمه إن المستقبل لمعاوية، وأن معاوية هو الذي يمثل القوى الكبيرة الضخمة في الأمة الإسلامية.
كان يعرف إن الصور الضخمة الكبيرة التي خلقها عمر وخلقها عثمان والتي خلقها الإنحراف هذه القوى، كلها إلى جانب معاوية، وهو ليس إلى جانبه ما يعادل هذه القوى، لكن مع هذا قبل الحكم، ومع هذا بدأ تصفية وتعرية الحكم والإنحراف الذي كان قبله، ومع هذا مارس الحكم وضحى في سبيل هذا الحكم بعشرات الآلاف من المسلمين، في سبيل أن يقدم الاطروحة الصحيحة الصريحة للإسلام وللحياة الإسلامية.
وقد قلت بالأمس، وأؤكد اليوم مرة أخرى بأن علي بن ابي طالب (عليه السلام) في معارضته، وعلي بن ابي طالب في حكمه لم يكن يؤثر على إنحراف الشيعة فقط، بل كان يؤثر على مجموع الأمة الإسلامية، علي بن ابي طالب ربى المسلمين جميعاً شيعة وسنة، حصن المسلمين جميعاً شيعة وسنة، علي بن ابي طالب أصبح اطروحة ومثلاً أعلى للإسلام الحقيقي، من الذي كان يحارب مع علي بن ابي طالب؟ هؤلاء المسلمون الذين كانوا يحاربون في سبيل هذه الاطروحة العالية في سبيل هذا المثل الأعلى، أكانوا كلهم شيعة بالمعنى الخاص؟ لا، لم يكونوا كلهم شيعة. هذه الجماهير التي انتفضت بعد علي بن ابي طالب علي مر التاريخ، بزعامات أهل البيت بزعامات العلويين الثائرين من أهل البيت، الذين كانوا يرفعون راية علي بن ابي طالب للحكم، هؤلاء كلهم شيعة؟
كان أكثرهم لا يؤمن بعلي بن ابي طالب إيماننا نحن الشيعة، ولكنهم كانوا ينظرون إلى الإمام علي أنه المثل الأعلى، إنه الرجل الصحيح الحقيقي للإسلام، حينما أعلن والي عبد اللّه بن الزبير سياسة عبد اللّه بن الزبير، وقال بأننا سوف نحكم بما كان يحكم به عمر وعثمان، وقامت جماهير المسلمين تقول لا بل بما كان يحكم به علي بن ابي طالب، فعلي بن ابي طالب كان يمثل اتجاهاً في مجموع الأمة الإسلامية.
والخلافة العباسية كيف قامت؟ كيف نشأت؟ قامت على أساس دعوة كانت تتبنى زعامة الصادق من آل محمد (صلى الله عليه وآله). الحركة السلمية التي على اساسها نشأت الخلافة العباسية كانت تأخذ البيعة للصالح، للإمام الصادق من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، يعني هذه الحركة استغلت عظمة الإسلام، عظمة هذا الإتجاه، وتجمع المسلمون حول هذا الإتجاه، ولم يكن هؤلاء مسلمين شيعة، أكثر هؤلاء لم يكونوا شيعة، لكن كانوا يعرفون أن الإتجاه الصالح، الإتجاه الحقيقي، الإتجاه الصلب العنيف كان يمثله علي بن ابي طالب (عليه السلام)، والواعون من أصحاب الإمام علي (عليه السلام ) والواعون من أبناء الإمام علي (عليه السلام). ولهذا كثير من أبناء العامة، ومن أئمة العامة، من أكابر أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، كانوا أناساً عامين يعني كانوا أناساً سنة، ولم يكونوا شيعة.
دائماً كان الأئمة (عليهم السلام) يفكرون، في أن يقدموا الإسلام لمجموع الأمة الإسلامية، أن يكونوا مناراً، أن يكونوا أطروحة، أن يكونوا مثلاً أعلى.
كانوا يعملون على خطين، خط بناء المسلمين الصالحين، وخط ضرب مثل أعلى لهؤلاء المسلمين، بقطع النظر عن كونهم شيعة أو سنة.
هناك علماء من أكابر علماء السنة، افتوا بوجوب الجهاد، وبوجوب القتال بين يدي ثوار آل محمد (صلى الله عليه وآله)، وأبو حنيفة قبل أن ينحرف، قبل أن يرشيه السلطان ويصبح من فقهاء عمال السلطان، أبو حنيفة نفسه الذي كان من نواب السنة، ومن زعماء السنة، هو نفسه خرج مقاتلاً ومجاهداً مع راية من رايات آل محمد وآل علي (عليه السلام)، وافتى بوجوب الجهاد مع راية من رايات الإمام علي (عليه السلام)، مع راية تحمل شعار علي بن ابي طالب، قبل أن يتعامل ابو حنيفة مع السلاطين.
إذن فاتجاه علي بن ابي طالب، لم يكن اتجاهاً منفرداً، اتجاهاً محدوداً، كان اتجاهاً واسعاً على مستوى الأمة الإسلامية كلها، لاجل أن يعرّف الأمة الإسلامية وأن يحصن الأمة الإسلامية بالإسلام، وبأهداف الإسلام، وكيف يمكن للإنسان أن يعيش الحياة الإسلامية في إطار المجتمع الإسلامي.
المهم من هذا الحديث، أن نأخذ العبرة وأن نقتدي، حينما نرى أن علي بن ابي طالب (عليه السلام) على عظمته يربي أصحابه على أنهم أصحاب الهدف، لا أصحاب نفسه. يجب أن لا أفكر انا، ويجب أن لا تفكر أنت، بأن تربي أصحابك على أنهم أصحابك، وإنما هم أصحاب الرسالة، أي واحد منكم ليس صاحباً للآخر، ولهذا يجب أن نجعل الهدف دائماً مقياساً، نجعل الرسالة دائماً مقياساً. أحكموا علي باللحظة التي أنحرف فيها عن الهدف، لأن الهدف هو الأعز والأغلى، هو رب الكون، الذي يجب أن تشعروا بأنه يملككم، بأنه بيده مصيركم، بيده مستقبلكم، أنه هو الذي يمكن أن يعطيكم نتائج جهادكم.
هل أنا أعطيكم نتائج جهادكم، أو أي إنسان على وجه الأرض يمكن أن يعطي الإنسان نتائج جهاده، نتائج عمله، نتائج إقدامه على صرف شبابه، حياته، عمره، زهده على تحمله آلام الحياة، تحمله للجوع تحمله للظلم، تحمله للضيم، من الذي يعطي أجر كل هذا؟ هل الذي يعطي أجر هذا أنا وأنت، لا أنا ولا أنت يعطي أجر هذا، وإنما الذي يعطي أجر هذا هو الهدف فقط. هذا هو الذي يعطي النتيجة والتقييم. هو الذي سوف يفتح أمامنا أبواب الجنة، هو الذي سوف يغير أعمالنا، هو الذي سوف يصحح درجاتنا.
إذن لا تفكروا في أن أي واحد منكم، في أن أي واحد منا، مرتبط مع أي واحد منا، بل فكروا هكذا: إن أي واحد منا مرتبط كله مع أكبر من أي واحد منا، هذا الشيء الذي هو أكبر، هو اللّه سبحانه هو رضوان اللّه، هو حماية الإسلام، هو العمل في خط الأئمة الأطهار (عليهم السلام).
الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر
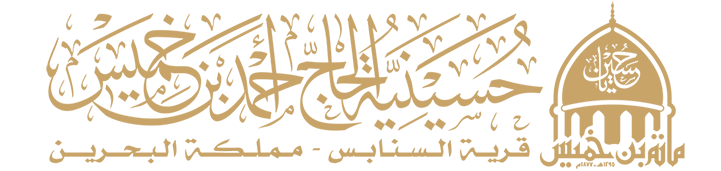



التعليقات (0)