أيها المحفل الكريم
إن مأساة تعيش في قلوب الناس وعقولهم وفي حياتهم الاجتماعية ألفاً وثلاثمائة وثلاثين سنة لهي مأساة أليمة حقا، لا بما نزل منها بالحسين رضي الله عنه فقط، بل بما تركت من آثارها المؤلمة في العالم الإسلامي كله. ولست هنا في مقام استنطاق التاريخ فأنا منذ خمسين سنة أدرس تاريخ صدر الإسلام وأمر بهذه المأساة كما يجس الطبيب الرفيق كف المريض.
ولقد دعيت إلى بغداد، في عام 1940، فتوليت في دار المعلمين العالية تدريس تلك الحقبة التي تمر فيها هذه المأساة بعد حوادث غير سارة كانت تطلّ برأسها في مدى عشرين عاماً.
والذي حدث إن هذه النائرة الهائجة قد هدأت منذ ذلك الحين، ذلك لأني لا أنظر إلى التاريخ من جانبه السياسي فقط بل من جانبه الاجتماعي أيضاً، بالإضافة إلى جوانبه الأخرى.
في التاريخ أحداث كثيرة تثير النفوس، ولكني لا أعرف حادثة بلغت في ذلك إلى ما بلغت إليه مأساة كربلاء لكثرة العناصر التي احتشدت على جانبيها. ولا أراني بحاجة إلى أن أفيض في الكلام عليها فإنها ليست معروفة فقط، بل هي محفوظة أيضاً. ولكني أراني بحاجة إلى بسط شئ من فلسفة التاريخ في ذلك.
حينما نأتي إلى تعليل التاريخ: إلى النظر في الأسباب والنتائج، لا إلى الاقتصار على القصة فقط، نرى أن الحادث التاريخي يجري بعوامل مختلفة تتفاوت في تأثيرها في كل حادث من الحوادث. هذه العوامل الفاعلة في مجرى أحداث التاريخ مختلفة الطبائع: تكون لاهوتية عند غير المسلمين، وتكون طبيعية وفلسفية واقتصادية ونفسانية ومثالية اجتماعية. وخير اوجه التعليل التاريخي التعليل الاجتماعي لأنه ينظر في فهم التاريخ إلى عوامل متعددة لا إلى عامل واحد، ويحسن أن نذكر أن المؤرخ ليس قاضيا بل حكم. انه ليس قاضيا لأن الحادث التاريخي إذا وقع لا يمكن رده. من أجل ذلك لا يستطيع المؤرخ أن يبطل حادثا من الأحداث ولا أن يصحح حادثا من الأحداث ولا أن يعاقب المسئ ـ لأن الذين تجري الأحداث على أيديهم أناس هم أقوى من المؤرخ ـ وكذلك لا يستطيع المؤرخ أن يرد الحق إلى أهله لأن الذين سلبوا ذلك الحق من أهله هم أيضاً أقوياء، وإنما رسالة المؤرخ أن يفهم الماضي ثم يفهمه للأجيال المقبلة وينبه تلك الأجيال إلى عثرات الماضي حتى لا تتكرر تلك العثرات في المستقبل. ولكن يبدو، مع الأسف، أن عثرات الماضي تعود مرة. ولذلك قيل في التاريخ، من جانب واحد على الأقل: التاريخ يعيد نفسه.
ثم إذا نحن أتينا إلى دراسة مأساة كربلاء، من حيث أسبابها ونتائجها، كما يقتضي تعليل التاريخ ـ أو فلسفة التاريخ ـ لم يخف وجه الحق فيها على احد. ولكن المؤرخ، كما قلت آنفاً لا يستطيع أن يدرس إلا ما وقع فعلا، ولا يستطيع أن يتمنى على التاريخ أن يسلك مسلكا معينا.
سأحاول أن اجعل من التاريخ قاضيا ـ مع أنني قد قلت من قبل أن المؤرخ يكون حكما ولا يستطيع، أن يكون قاضيا ـ وسأجعل ذلك المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون، واعتقد انه مؤرخ مقبول الرأي في كثير من الأمور. وقد كنت لجأت إليه في عام 1940 في معالجة هذه القضية نفسها. لا بد من أن أعود إليه في الوقت الحاضر إقراراً بفضله علي منذ أربعين عاماً أو تقل قليلا.
يقول ابن خلدون في هذه القضية:
(ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه: فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك، كما فعل الحسين وعبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ ومن اتبعهما في ذلك).
ثم يتابع القول فيقول: (وأما الحسين فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره، بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة إلى الحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره، فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه، ولا سيما (عند) من له القدرة على ذلك، وظنها من نفسه وأهليته وشوكته (أي قوته وسلاحه. فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة.... ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء (الفاسدة)؟.
هذه جمل من مقدمة ابن خلدون أوردتها بنصها، ولا أظن أن أحداً من أهل المشرق أو من أهل المغرب يخالفه فيها.
فمأساة كربلاء ـ عند ابن خلدون وعند العارفين بالتاريخ وبتعليل التاريخ ـ لم تقع لأن الحسين، رضي الله عنه، لم يكن أهلا للخلافة. لا، أن الحسين كان بتقواه ومكانته وعدالته أهلا للخلافة وأحق بها.
ولكن مأساة كربلاء وقعت في التاريخ لأن عصبية بني أمية كانت أقوى من عصبية بني هاشم. ويعني ابن خلدون بالعصبية القوة السياسية والحربية. فابن خلدون، في منطق التاريخ، قد حكم للحسين على يزيد ـ وهذا إقرار بحق لا فضل لابن خلدون في الإقرار به، ولكن لم يكن ابن خلدون ـ كما لم يكن أحد غير ابن خلدون ـ قادرا على أن يبدّل ما حدث في كربلاء. ولقد قال ابن خلدون بوضوح وبالحرف الواحد:
(فلا يجوز ليزيد قتال الحسين، بل هو من فعلاته المؤكدة لفسقه. والحسين فيها شهيد مثال، وهو على حق واجتهاد…
ذلك هو التاريخ السياسي: حادث وقع لا يستطاع رده. ولم يكن في طوق المؤرخ العاقل المنصف أن يفعل أكثر مما فعله ابن خلدون حينما حكم للحسين، رضي الله عنه، بالحق والعدالة والاستحقاق ثم حكم على يزيد ـ في شأن قتاله للحسين ـ بالفسق. ولكن كيف نقرأ نحن الآن تاريخنا الاجتماعي، وما يجب على المسلمين جميعاً أن يفعلوا في حاضرهم؟ ما العبرة التي يجب ان نقتبسها من مأساة كربلاء ومن الدرس الذي ألقاه علينا الحسين، رضي الله عنه، ووجب علينا أن نتعلمه؟
إني أراني بحاجة إلى الاستقراء مرة ثانية، سأنحدر في التاريخ أربعة قرون: سأذهب إلى إخوان الصفا، فإن اسم الحسين ورد في رسائلهم مرارا. إن إخوان الصفا كانوا يذهبون مذهب الرمز في رسائلهم فيذكرون آدم وإبراهيم وعيسى وسقراط وعليا والحسين وغيرهم من رجال الأمم ذكرا فيه شئ قليل من التاريخ وشئ كثير من الرمز. فالحسين مثلا رمز لكل من استشهد في سبيل مبدأه. وبهذا النظر لا يبقى العلم التاريخي عندهم متحيزا في مكانه الأول بل يصبح جزءا من التاريخ الجاري. إن سقراط، مثلا، لايبقى الفيلسوف اليوناني القديم الذي شرب السم مطمئنا كيلا يرجع عن الرأي الصواب إلى رأي خاطئ، بل يكون كل إنسان في كل مكان وزمان هو سقراط إذا هو آثر إنهاء حياته برضاه على أن يترك الأمر الصواب الذي جعله ووكداً له في الحياة.
وبهذا المعنى نفسه لا تبقى كربلاء، في نظر إخوان الصفا بلدة في جنوبي العراق شهدت مأساة، بل يصبح كل قطر من أقطار البلاد الاسلامية كربلاء ينهض فيها رجل ليعلن كلمة الحق ثم يدفع حياته ثمنا في نصرة كلمة الحق.
وليس عليه بعدئذ أن يصل هو إلى ما أراد، بل انه سيبقى هو رمزا للدفاع عن الحق يتتابع بعده المجاهدون والشهداء إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
نحن المسلمين اليوم في جميع بقاع الارض بحاجة إلى أن ينهض فينا (حسين) يدلنا على الطريق السوي في الدفاع عن الحق الذي لا يكون في يوم ذات اليمين وفي يوم آخر ذات الشمال. لسنا نحن الذين يجعل الحق هو الحق بل نحن الذين يجب علينا أن نقرّ بالحق حين نرى الحق ملئ أعيننا. والحق لا يكون اثنين، والحق لا يفرق بين المتفقين ولكنه يوحّد المختلفين.
وأريد الآن أن ارجع إلى تاريخ الحسين، رضي الله تعالى عنه، ولكن لا أقصد التاريخ السياسي الذي هو القصة، وإنما اقصد التاريخ الاجتماعي الذي هو القوانين الفاعلة في الحياة من أسباب الأحداث ونتائجها. اقصد التاريخ العاقل الذي يجري على أيدي الجلة من الناس.
الحياة سلسلة متعانقة الحلقات، تتتابع حلقاتها على سمت مقدر وعلى منطق واضح، وليست حوادث مفردة متفرقة تنبت هنا وهنالك على ما يهوى الأفراد أو تتجه إلى الجانب الذي يحبه بعض الناس أو يكرهه بعض الناس. إن الحياة إرث ثمين يتلقاه المتأخرون في الحياة عن المتقدمين فيها؛ ثم ترسخ قوانينها في النفوس فتصبح وكأنها طبائع مغروزة لا تتغير ولا تتبدل.
يخبرنا التاريخ العاقل أن علياً كرم الله وجهه لم يكن يعطي ولديه الحسن والحسين من بيت المال إلا ما كان حقا لهما في الديوان، فقد كان علي لا يأخذ ولا يعطي إلا الحق، حتى أن أخاه عقيلا ـ وهو شقيقه ابن أبيه وأمه ـ طلب من بيت المال شيئا لم يكن له بحق، كما يقول ابن الطقطقي في كتابه (الفخري) (ص85 من طبعة دار بيروت) فمنعه علي (عليه السلام) وقال: يا اخي، ليس لك في هذا المال غير ما أعطيتك. ولكن اصبر حتى يجئ مالي فأعطيك منه ما تريد. فلم يرض عقيل هذا الجواب ففارقه وقصد معاوية..) إن هذا شئ من الحق والعزم والعقل ينتقل مع الإرث الاجتماعي في الحياة من الأب إلى ابنه، ومن الأستاذ إلى تلميذه، ومن الحاكم إلى المحكوم، على منحى القوانين الاجتماعية.
وقد اتفق أن انتقل هذا الإرث الثمين إلى الحسن بن علي، رضي الله عنهما، ولم ينتقل إلى عقيل أخ علي وشقيقه.
ومن المشهور في التاريخ أن علياً، كرم الله وجهه، لما طعن وأيقن أنه ميّت التفت إلى أهله الذين حوله وقال لهم هذه الكلمة العالية: (النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوا قاتلي كما قتلني. وإن أنا بقيت رأيت رأيي فيه. يا بني عبد المطلب، لا تتجمعوا من كل صوب تقولون قتل أمير المؤمنين. ألا لا يقتلنّ بي إلا قاتلي). فانظروا إلى رجل لا يصرفه الموت عن قول الحق وعن فعل العدل. ذلك من كرم الأخلاق الذي اتفق أن انتقل من علي، كرم الله وجهه، إلى ابنه الحسين.
هذا الاتجاه السليم في الحياة: الفصل بين الخدمة والعاطفة الخاصة إنما من سجايا النفوس الكبيرة. إن الحسين لم يأب أن يذهب إلى الجهاد بقيادة قائد أموي وباسم خليفة أموي ومع نفر فرقت بينهم السياسة، ما دام هذا الجهاد في سبيل الإسلام، وفي سبيل الله.
وفي تاريخ ابن الأثير (3:161) لما ثارت الفتنة في أواخر أيام عثمان بن عفان، وجاءت الوفود من المماصر المختلفة وحاصرت عثمان تريد قتله ثم قتلته، كان ممن استقتل مع عثمان في الدفاع عن الخلافة وكرامتها نفر من أهل المدينة منهم سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة.
وإذا كان بنو هاشم يجدون في صدورهم شيئا من بني أمية، فإن هذه الموجة كانت بين الأفراد ولم تتعد، في نفس الحسين، رضي الله عنه، إلى خذلان خليفة المسلمين. وتلك مأثرة نادرة في حياة الرجال.
ولا سبيل إلى إنكار النفرة التي وقعت بين معاوية وعلي، وخصوصا بعد أن حدث التحكيم بعد صفين وبعد خدعة عمرو بن العاص وبعد أن نادى معاوية بنفسه خليفة فانقسم العالم الإسلامي بين خليفتين: خليفة كانت الوفود من أقطار البلاد الإسلامية قد بايعته وخليفة نادى بنفسه في جماعة من قومه.
ولما توفي الحسن، سنة 50 للهجرة، كان سعيد بن العاص والياً على المدينة. وكان الحسن قد وصى أن يدفن عند جده رسول الله، إلا أن تخاف الفتنة فيدفن في مقابر المسلمين. يقول ابن الأثير (3:460):
فاستأذن الحسين عائشة في ذلك فأذعنت له، ولم يعرض إليه سعيد بن العاص وهو والي المدينة.ولكن مروان بن الحكم جمع قوماً من بني أمية واعترض الناس ومنع دفن الحسن إلى قرب رسول الله. فعزم الحسين على أن يقاوم مروان ومن معه. فقيل للحسين: إن أخاك قد قال: إذا خفتم فتنة فليكن الدفن في مقابر المسلمين العامة، وهذه المقاومة لنبي أمية يمكن أن يكون منها فتنة. فقنع الحسين، رضي الله عنه، ولم يقاوم الذين قاوموه، مع أن ما أراده كان حقا له. ولكن الحسين أدرك بعقله الراجح أن التنازل عن حق شخصي أفضل من التعرض لفتنة عامة.
إن هذا الأفق الواضح المنفرج أمام الحسين، رضي الله عنه، لا يكون إلا القليلين من الناس الذين حباهم الله خلقا كريما يستطيعون به أن يضحوا المصلحة الشخصية الفردية في سبيل المصلحة الجامعة العامة. نحن نفتقد اليوم مثل هذه الفضيلة في كثير من رجالنا. ولكن ما كل رجل حسيناً.
نحن في التاريخ لا نقول: لو ولولا. نحن في التاريخ نذكر ما حدث ثم نسأل: لماذا حدث ذلك الذي حدث؟
الثورة على الظلم مألوفة في التاريخ، ولكن تلك الثورة على الظلم تختلف أسبابها ونتائجها بين حين وحين. وأسباب ثورة الحسين على الظلم كانت موجودة منذ أيام معاوية، ولكن تلك الثورة المنتظرة لم تنشب في أيام معاوية، بل اتفق أن نشبت في أيام يزيد. وسبب ذلك هو الاختلاف في المقدرة السياسية بين معاوية وابنه يزيد.
وفي تعليل التاريخ أن من أسباب سقوط الدول تعاقب حكام ضعاف وأقوياء: يكون الحكم قويا فيضبط الناس ضبطاً شديداً، ثم يخلفه حاكم ضعيف فيفلت زمام الناس من يده. فإذا خلف هذا الضعيف حاكم آخر قوي صعب عليه أن يعيد الناس إلى النظام والطاعة.
ولكن العلم شئ وسياسة الدول والشعوب شئ آخر. ومما يدل على قصور يزيد في الحكمة السياسية أن معاوية كان قد نصحه في عدد من الأمور التي تتعلق بالأشخاص الذين يمكن أن ينازعوه الخلافة أو يثيرون العواطف عليه وسماهم له واحداً. ومما قاله له في شأن الحسين، رضي الله عنه (الفخري:112): (.. فإن خرج وظفرت به فاصفح عنه فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماً وقرابة من محمد صلوات الله عليه وسلامه).
وكان من سوء حظ يزيد، ومن سوء حظ المسلمين، أن يزيد لم يسمع في ذلك نصح أبيه فلم يتدارك الكارثة قبل وقوعها، وكان ذلك ـ لو أراد ـ أمراً يسيرا، فإن الحسين سلك قبيل الكارثة مسلكاً عالياً من العدل الرفيع والخلق الكريم.
أما أنا إذا جئت إلى هذه الكارثة أو المأساة في تاريخ الإسلام فإني لن اعرج عليها ـ من حيث القصص ـ بشئ وأقول مع ابن الطقطقي (الفخري:113):
(هذه قضية لا أحب بسط القول فيها استعظاماً لها واستفظاعاً، فإنها قضية لم يجر في الاسلام أعظم فحشاً منها).
ولكن لا مفر من أن نأتي إليها من جانب التعليل، فإن تعليل أحداثها والمغزى منها هما المقصود من هذا الحديث كله.
لما نظر الحسين، رضي الله عنه، إلى الدولة ورأى ما فيها من الظلم أدرك انه لا بد من عمل شئ،. إن هذا الذي كان يحدث في الحكم كان منكرا يجب تغييره. والخلافة منصب له شروط. أما تعريف الخلافة، كما نجد في مقدمة ابن خلدون، فهي نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا (المقدمة، المطبعة الأدبية، ط3 ص190).
وشرح ابن خلدون قوله هذا فقال: ن هذه النيابة عن صاحب الشريعة تسمى (خلافة وإمامة، والقائم بها خليفة وإماماً. فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبرى. وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله. وكذلك نصب الإمام، كما يرى ابن خلدون أيضاً، واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين. وهذا الإجماع على نصب الإمام بالإجماع هو قضاء بحكم العقل. ولقد وجب نصب الإمام بحكم العقل لضرورة الاجتماع للبشر ولاستحالة حياتهم ووجودهم منفردين).
ثم يذكر ابن خلدون أن جماعة من الناس قد شذوا عن ذلك فقالوا أن نصب الإمام غير واجب لا بالشرع ولا بالعقل. وقد سفه ابن خلدون هذا الرأي وفنّد أدلة هؤلاء على السبب الذي دعاهم إلى ما ذهبوا إليه. وكذلك أورد ابن خلدون تعريف الشيعة للإمامة وأنها ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفال (منصب) الإمامة ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب تعيين الإمام لهم..) غير أن ابن خلدون يعتمد العامل الاجتماعي في تعليل أحداث التاريخ حتى يرى أن وجوب الخلافة أو الإمامة الكبرى بالعقل أو بالشرع إنما هو لضرورة الاجتماع البشري في هذه الدنيا.
ولا شك في أن الحسين، رضي الله عنه، كان يفكر في رفع الظلم الذي يراه في زمانه: أيقدم على رفع الظلم بالكلمة اللينة أو بالنصيحة القاسية أو بالجدال أو بالحرب. إن السكوت على الظلم لا يجوز بحال.
وفيما كان هو في التفكير وفي المفاضلة بين تلك الوسائل التي كانت تجول في خاطره جاء إليه جماعات من الناس وكتب إليه جماعات آخرون وكلهم يطلب منه اللجوء إلى الحرب لتغيير المنكر ويعرض عليه أن ينصره في ذلك.
عندئذ تعين عليه أن يجيب أولئك الجماعات وأن يختار اللجوء إلى القوة لأن اللجوء إلى القوة كان الوسيلة التي عرضت عليه، وكان هو يفكر بمثلها وبها أيضاً. من أجل ذلك عزم الحسين، رضي الله عنه، في نفسه على أن يخرج مجاهداً كما اختار أن يذهب إلى المكان الذي دعاه الناس إليه للبدء بذلك الجهاد.
ولما عزم الحسين على الجهاد لم تبق تلك العزيمة من أثر طلب الناس لها، بل أصبحت تلك العزيمة اقتناعا ذاتيا منه. ثم بطل أن يكون لسائر الناس حتى لأولئك الذين طلبوا منه الخروج للقتال ـ صلة بها.
وجرى الاجتماع الإنساني مجراه الطبيعي المألوف:
ليس البشر سواء في العزيمة والجهد والفكر والعمل. إن أولئك الذين هالهم الفساد فثارت نفوسهم فحملوا تلك الثورة في نفوسهم إلى الحسين، رضي الله عنه، وشكوا إليه ما يتألمون منه، قد بردت نفوسهم بعدما أ بثوا شكواهم إلى من كانوا يعتقدون أنه القادر على ما يطلبون منه. وسرعان ما نسيت تلك الجموع البشرية إنها كانت تطالب برفع ظلم وقع عليها. وقد قيل إن الناس سموا أناساً من النسيان. ولقد كان هذا النسيان عاما في جميع طبقات الشاكين.
وخرج الحسين، رضي الله عنه من المدينة متوجها نحو العراق. وفي أثناء الطريق لقي الشاعر الفرزدق فسأله عن القوم، فقال له: قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية! ولكن الحسين كان قد عزم في نفسه على رفع الظلم بالقوة، لم يأبه بما نقله إليه الفرزدق ـ مع أن الفرزدق قد عرف في تاريخ الأدب بأنه شاعر آل البيت ـ ومضى الحسين في طريقه لأنه كان قد عزم على أمر. إن تبدّل رأي الناس قد بدل مسلك الناس ولكن لم يبدل مسلك الحسين.
ووصل الحسين إلى العراق ورأى أن قلوب الناس قد تغيرت ـ والقصة في ذلك معروفة مشهورة ـ فلم يبدل رأيه فيما كان قد عقد عليه قلبه. وكان التاريخ يجري بقوانينه التي تشبه أن تكون قوانين طبيعية. ليس البشر سواء في كل شئ، ولا هم سواء في شئ ما أيضاً. والذين تدفعهم المثل العليا أفراد، أما الجماعات الكثيرة فإن مصالحهم تسير بهم ذات اليمين وذات اليسار. وفي العراق قيل له: إن قاتلت قتلت. فلم يستغرب ذلك لأن جميع الدلائل كانت تشير إلى نتيجة ما أقدم عليه. وقال لمحدثه: (أبالموت تخوفني؟) ذلك لأن الحسين كان عقد عزمه على أمر ولم يكن يريد أن يبطل هذا لعزم مهما تكن الأحوال والأهوال ومهما تكن المثبطات والمعوقات.
ولا أريد أن أمضي بكم في قص أخبار كربلاء يوماً يوماً، فإن قصة ذلك شائعة. ولكن أريد أن أورد رواية لابن الأثير (4:43). لما رأى الحسين أن الكثرة من الناس قد خذلته، التفت إلى القلة الباقية حوله وقال لهم: (من شاء منكم أن ينصرف لينصرف)، إدراكاً منه أن يكون نفر من هؤلاء قد حبسهم الحياء حوله.
فأخذ الناس ينصرفون حتى لم يبق حوله ممن كان قد وعده النصرة لا كثير ولا قليل. ومع ذلك فإن عزمه بقي بعد أن تفرق جميع الناس عنه كما كان يوم كان يظن أن أربعين ألف سيف ستقاتل معه.
ثم كانت كربلاء وكانت المأساة في كربلاء.
إن المسلمين يمرون اليوم في مثل أيام كربلاء، من الفيليبين في أقصى المشرق إلى ساحل البحر الأخضر من أقصى المغرب. والاسلام نفسه يمر في محنة، يوما من الشرق ويوما من الغرب، وحينا على يد غريبة، وحينا على يد قريبة، ومن الناس من لا يذكر الاسلام إلا إذا حزبه الأمر أو إذا أراد أن يلقى ستارا على جانب من الحاضر.
مر معنا أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن ليس بمعنى أن الحادث التاريخي يعود إلى المجتمع مرة بعد مرة، ولكن بمعنى أن الأسباب المعينة التي كنت في الماضي قد أدت إلى وقوع حادث من الأحداث، إذا اجتمع مثلها مرة ثانية فيمكن أن يؤدي اجتماعها الثاني إلى وقوع مثل الحادث الأول. إذا خاض قوم معركة وهم مختلفوا الهوى قليلوا العدة قصيروا النظر لا يعرفون ما يريدون، فإن أمرهم يصير إلى الفشل، أي إلى الضعف، فينهزمون في تلك المعركة قبل أن يهزمهم عدوهم. ذلك قانون من قوانين التاريخ. فإذا خاض هؤلاء القوم معركة ثانية وهم على مثل الحال التي كانت فيهم يوم خاضوا المعركة الأولى، فلا ريب في أن نتيجة المعركة الثانية ستكون كنتيجة المعركة الأولى سواء بسواء.
وليس يفيد المسلمين اليوم أن يعتذروا من هزائمهم المتوالية بالامبريالية العالمية وبالأحوال الدولية وبكذا وكذا مما لا أحب أن أسميه. أنا لا أريد أن أنكر الأسباب الخارجية التي تساعد على ضعف المسلمين في حاضرهم، ولكني أريد أن نسأل أنفسنا: ما الذي نفعله نحن في سبيل دفع الشر عنا.
لا العلم الصحيح نريد أن نتعلمه، ولا الاقتصاد الصحيح نريد أن نأخذ به، ولا الحضارة الحقيقة نريد أن نتسم بها ولا الرجل الناصح نريد أن نسمع منه ما يقول. لقد بدا لكم منذ مطلع حديثي أنني لا أنظر إلى مأساة كربلاء على أنها حادث تاريخي فقط، بل على أنها أيضاً حقيقة اجتماعية تتبدى كل يوم في حياة المسلمين. ألم تكن مأساة كربلاء خذلان الناس للقائد المخلّص الذي أراد أن يمسح الظلم عن المجتمع بكفه الكريمة؟ ألا نحتاج اليوم في كثير من بلاد الإسلام إلى من يفعل مثل ذلك؟
إن كربلاء، إذن، ليست ذكرى هزيمة في معركة، ولا هي فقط رمز لفساد سياسي ومحاولة لإصلاح لم يتم إلا بعد أمد ثم عاد الفساد سيرته الأولى. إن لنا، نحن المسلمين، اليوم كربلاء، في كل ميدان من ميادين حياتنا. في العلم، في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، في الدين، في الأدب والشعر، في الصناعة، في التجارة، وفي كل ما يخطر لنا ببال وما لا يخطر لنا ببال. لا يجدينا أن ننكر أننا متخلّفون في نواح كثيرة من جوانب حياتنا، بل يجدينا أن نقرّ بحاضرنا الشقي بالإضافة إلى بلاد العالم الراقية رقياً حقيقياً والقوية قوة حقيقية.
للعاطفة، أيها المحفل الكريم، جانب من حياة الفرد والجماعة لا ينكر. فإن فردا أو مجموعة لا عاطفة له ليس كائنا تام الإنسانية.
ولكن للعقل أيضاً جانباً لا ينكر. والعاطفة حال عارضة في الإنسان، ولكن العقل هو القاعدة في السلوك الإنساني.
وللإنسان جانبان من العاطفة: جانب الحزن وجانب الفرح، ولا شك في أن جانب الحزن أقدر على جمع بعض البشر إلى بعض.
ويكفينا مثلا على ذلك ما نحن فيه من ذكرى الحسين: تلك الذكرى التي يجتمع لها الناس في العالم الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا. ولكن الإنسان يحاول في كل أمره أن يكون لكل شئ في حياته جانب عملي نافع.
وفي نهاية حديثي أريد أن أقول:
إذا نحن نظرنا إلى مأساة كربلاء على أنها حادث من أحداث التاريخ كحرب البسوس أو كيوم ذي قار أو كمعركة القادسية أو كحصار القسطنطينية فإننا لا نعدو بمأساة كربلاء أن تكون حادثة من ألوف الحوادث التي مرت في التاريخ، ويكون الحسين، رضي الله عنه، حينئذ ـ بهذا النظر القاصر ـ قائد حملة لم يكتب لها النجاح. أما إذا نظرنا إلى مأساة كربلاء على أنها (كلمة حق في وجه حاكم جائر)، ثم عزمنا على أن نجعل من تلك الكلمة من الحق معلماً في تاريخنا وقدوة في حياتنا، نقف في كل قضية لنا كما وقف الحسين قبل كربلاء ويوم كربلاء، فإننا نكون قد وضعنا يوم كربلاء في إطاره الصحيح من تاريخ الاسلام ونكون قد جعلنا من عمل الحسين أسوة لنا ننتفع بها في سلوكنا اليومي وفي معالجة قضايانا.
إذا لم يكن كل واحد منا أن يتصف بجميع فضائل أبطالنا في تاريخ الإسلام، فلا أقل من أن نحاول التأسي بهم في بعض فضائلهم.
وتاريخنا الحاضر يحتاج ـ مع الأسف ـ في كل يوم إلى قدوة بالحسين بن علي، رضي الله عنهما.
والسلام عليكم ورحمة الله
___________________________________
الهوامش
1 - ولد عمر فروخ في بيروت سنة 1906، حصل على الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا عام 1937، كان عضوا في مجتمع القاهرة ودمشق وبومباي، ونال ستة أوسمة من أقطار عربية وأجنبية، له مؤلفات قيمة كثيرة، وتوفي سنة 1987.
كتبت هذه المحاضرة في9/12/1977م وألقيت في احتفالات العشر الأوائل من المحرم (في الكويت) لمناسبة عاشوراء المحرم) من سنة 1398 للهجرة.
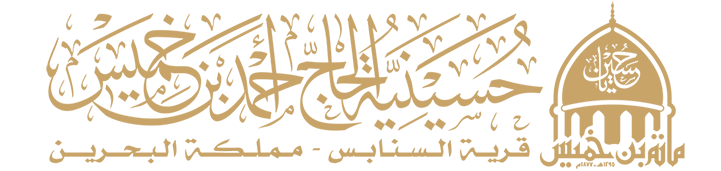



التعليقات (0)